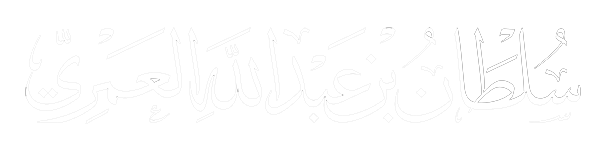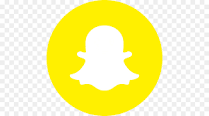26- إذا كان التفريط في الوضوء مذموماً فكذلك الإفراط والوسواس مذموم.
28- حديث " فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده " الصحيح أنه عام في نوم الليل والنهار؛ لأن العلة التي ذكرها الشارع موجودة في نوم الليل والنهار.
30- لفظ "وعفِّروه الثامنة بالتراب " شاذ ولا يؤخذ به ويترك المتواتر.
30- وأما أثر الكلب في الصيد فلم يؤمر بغسله، بل هو طاهر لأجل الحاجة.
32- إذا توضأ في آنية محرمة صحت طهارته مع الإثم؛ لأن القاعدة في المحرم أنه إن عاد التحريم على نفس العبادة بطلت العبادة بفعله، وإن عاد التحريم على أمر خارجي لم تفسد العبادة به.
36- من أبيات نونية ابن القيم:
واحفظ حدود الرب لا تتعدها
وكذاك لا تجنح إلى النقصان
وانظر إلى فعل الرسول تجده
قد أبدى المراد وجاء بالتبيان
49- اشترط الفقهاء لجواز المسح على الخف شروطاً لم يثبت منها إلا شرطان: كونه يُسمَّى خفاً وأن يُلبس على طهارة.
51- في حديث المذي " يغسل ذكره ويتوضأ " هل يغسل الانثيين مع الذكر؟
قولان؛ وقد ورد الأمر بغسلهما مع الذكر، وفيه منفعة طبية؛ لأن سببه الحرارة والشهوة، وغسا الانثيين يزيل الحرارة.
56- شعور البدن على أقسام:
1- تجب إزالته؛ كالإبط، والعانة، إذا كثرا.
2- يحرم إزالته؛ كاللحية والحاجبين.
3- يستحب إزالته؛ كالعانة والإبط إذا لم يكثر.
4- لا تكره إزالته ولا إبقاؤه؛ باقي شعور البدن.
57- سُمي الجُنب بذلك؛ لأن ماء المني باعد محله، وقيل: لأن الجُنب يجتنب عما يفعله حال طهارته، وقيل: لأنه بعيد عن الأرواح الطيبة.
57- موجبات الغُسل خمسة بالإجماع، والسادس فيه خلاف:
- 1- خروج المني دفقاً بلذة.
- 2- إيلاج الحشفة في الفرج ولو لم ينزل.
- 3- الحيض.
- 4- النفاس.
- 5- الموت.
- 6- غسل الكافر، والصواب لا يجب.
91- شرط وقت الصلاة مُقدَّم على سائر الشروط، فلو تيقن أنه يجد سترة وماء بعد خروج الوقت، وجب عليه الصلاة عرياناً بتيمم في الوقت.
91- وجوب الترتيب في قضاء الفوائت إلا في:
-
1- إذا خشي خروج وقت الحاضرة.
-
2- أو خشي فوات الجماعة، وتدرك بركعة على الصحيح.
-
3- إذا نسيها حتى صلى التي تليها، وأما لو ذكر في نفس الصلاة فيقطعها إلا إذا كان في جماعة.
-
4- إذا كان جاهلاً بوجوب التقديم فيعذر.
107- الصواب وجوب تسوية الصفوف لترتب الوعيد " أو ليخالفن الله بين وجوهكم "، والمراد: المخالفة بين القلوب فلا يحب لأخيه الخير.
108- المرأة مع الرجال تصف لوحدها، وأما مع النساء فتصلي معهم وجوباً ويسوون صفوفهم ولا تنفرد عنهم.
111- سبب تأليف الإمام أحمد كتابه الصلاة؛ أنه صلّى في مسجد فرأى كثرة مسابقتهم للإمام فصنّفه.
114- إذا كان الرجل لا يقوى على القيام في الصلاة ولكنه يقوى على حضور الجماعة فيجب عليه الصلاة في المسجد ويُصلي جالساً.
117- كل نص ترتب عليه مغفرة الذنوب فالمراد به الصغائر، وأما الكبائر فلا بد لها من توبة.
118- أيهما أفضل كثرة الركوع والسجود أو طول القيام؟
قال أحمد كلاماً جامعاً: انظر ما هو الأصلح لقلبك فافعله.
112- دعاء الاستفتاح " سبحانك اللهم " اختاره أحمد لما اشتمل عليه من الثناء، ولأن عمر رضي الله عنه كان يجهر به في الفرائض ليعلمه الناس.
128- في الأعضاء السبعة يستحب ألا يجعل بينها وبين الأرض حائل إلا الركبتين لئلا تنكشف العورة.
129- الصحيح وجوب تكبيرات الانتقال وهي من مفردات أحمد، والبقية يرون الاستحباب.
142- حديث الصحابي الذي كان يقرأ الإخلاص في كل ركعة ويختم بها.
فيه جواز قراءة سورتين في الركعة.
145- البسملة لم تذكر قبل سورة براءة؛ لأنها سورة غضب وتُسمَّى الفاضحة؛ لأنها فضحت المنافقين.
147- هناك السهو عن الصلاة، والسهو في الصلاة.
فالسهو عن الصلاة دليل التهاون بها، كما قال تعالى " والذين هم عن صلاتهم ساهون " وأما السهو في الصلاة فلا بأس به وقد جرى لنبينا وغيره، وفيه سجود السهو.
156- اختص الكلب الأسود بأنه يقطع الصلاة، وأنه يحل قتله في الحل والحرم ولو لم يكن عقوراً، ولا يحل في الصيد والحرث.
158- القهقهة تبطل الصلاة بخلاف التبسم فهو مكروه.
159- الإبراد لا يشرع في الجمعة؛ لأنه يشق على الناس، ولأن الناس يبكرون لها.
164- ستر أحد العاتقين سنة، وهو الصحيح خلافاً لأحمد.
165- سُمَّي التشهد بذلك؛ لأن فيه لفظ التشهد.
174- في قوله تعالى " وأما السائل فلا تنهر " قيل: سائل العلم، وقيل: سائل المال، والصحيح أنه عام لهما.
190- القصر في الصلاة مُستحب، وهو أفضل من الإتمام، ولو أتم قيل لم يجزئه، والصواب أنها تجزئه، لكن يكره الإتمام، وليس له سبب شرعي إلا السفر بالإجماع.
193- غُسل الجمعة مُستحب جداً إلا على من به رائحة وسخ ونحوه فيجب.
196- الكلام حال الخطبة مُحرم إلا للإمام ومَن يكلمه، وقيل الذي لا يسمع الخطبة لبعد لا لطرش.
196- وأما مُجاوبة الإمام بالذِكرِ والسؤال والصلاة على النبي فالجهر بذلك مكروه.
197- ساعات الجمعة؛ الصحيح أنها تبدأ بعد طلوع الشمس.
201- العيد عند الكفار موسم للفرح والأكل؛ لأنهم كالبهائم، وأما عند المسلمين فالعيد فرح وسرور وعبادة؛ لأنه فرح بفضل الله عليهم.
206- حديث " شاتك شاة لحم " أي ليست شاة نسك؛ لأن الذبح إما للنسك كالأضاحي والهدايا والعقائق، أي أنه بالأصل للنسك واللحم تبع، وإما أن يكون الذبح للحم فقط كما في غير ذلك من الذبح.
211- العيد لا يُنادى لها بالصلاة جامعة، ولا تُقاس على الكسوف؛ لأن الكسوف يقع بغتة لا يعلم به الكثير من الناس بخلاف العيد.
214- الكسوف، لا يُستحب إعادتها، ولو فرغ من الصلاة قبل نهاية الكسوف لم يعد، ويدعو حتى تنكشف.
216- الصحيح أن الخطبة بعد الكسوف مُستحبة لحاجة الناس للوعظ في هذا الزمن.
220- في حديث الكسوف قال صلى الله عليه وسلم: " إن هذه الآيات التي يرسلها الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته ".
فيه استحباب الصلاة لجميع الآيات التي تقع خارقة للعادة كالزلزلة والظلمة بالنهار وكثرة الرمي بالشُهب، ونحو ذلك، ومذهب أحمد لا يُصلى لشيء من الآيات غير الزلزلة والكسوف.
222- خطبة الاستسقاء قيل قبل الصلاة وقيل بعدها، وكلها روايات في مذهب أحمد.
227- صلاة الخوف، أضيفت لسببها كصلاة العيد والجمعة والكسوف.
234- عبارة بعضهم في فرض الكفاية " إن قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإلا أثم الناس كلهم " فيها نظر، لأن الإثم خاص بمن علم وقدر على ذلك.
237- الصلاة على الميت الغائب؛ على خلاف، فقيل:
-
1- تشرع مطلقاً.
-
2- لا تشرع مطلقاً.
-
3- تشرع للمصلحة، فإذا كان الميت ملكاً صالحاً أو عالماً، وأما إن كان من سائر الناس فلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي على من مات غائباً، وإنما صلى على النجاشي، وهذا أصح الأقوال.
239- الصلاة على الميت المدفون، قيل آخر مدة هي شهر؛ لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على شخص بعد شهر، ولأنه يبلى بعد ذلك، والتحديد فيه نظر، ولا مانع من الصلاة بعده؛ لأن الصلاة على الروح لا على الجسد.
242- لو ماتت امرأة مع رجال وليس هناك مُغسلات ولا محرم فلا تغسل، بل تيمم.
244- من حديث " فإنه يبعث ملبياً ".
يؤخذ منه أن المسلم إذا شرع في عمل صالح ومن نيته إكماله ثم يموت، فإنه يجري عمله إلى يوم القيامة وتبلغ النية مبلغ العمل في هذه الحال.
245- في زيارة النساء للقبور استثنى بعضهم زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يباح لهن، قال السعدي: وقد تعبنا بطلب الدليل على استثنائه فلم نجد لذلك دليلاً.
246- حديث " أسرعوا بالجنازة " ليس المراد الإسراع بحملها، بل يشمل تجهيزها وتغسيلها.
252- الإيمان نوعان:
- 1- نوع يمنع من دخول النار.
- 2- لا يمنع من دخولها ولكن يمنع الخلود فيها.
262- زكاة الحبوب والثمار، فيها العُشر إن كانت تُسقى بلا مؤمنة كالعيون والأمطار، ونصف العشر فيما يُسقى بكلفة، ولا يشترط لها تمام الحول، بل وقت أخذ الثمر.
275- زكاة الفطر مصرفها مصرف الزكاة، لكن الأولى دفعها للفقراء؛ لأنها قليلة ولا يستشرف لها.
284- فعل المحظور في جميع العبادات على وجه النسيان أو الجهل أو الخطأ لا يبطل العبادة.
286- الكفارات المتعلقة بالمفطرات في رمضان:
الجماع في نهاره هو الذي فيه كفارة، وأما بقية المفطرات فلا كفارة فيها، وكذلك لو جامع في صيام في غير رمضان فلا كفارة، وذلك لأن الكفارة لحرمة زمان رمضان.
287- في قصة كفارة المجامع في نهار رمضان بعد أن أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم التمر، قال: " وجدت عندكم الضيق، وعند رسول الله السعة ". رواه أحمد.
287- هل تسقط الكفارة حينما يعجز عنها؟
في قصة المجامع قال الرسول صلى الله عليه وسلم: " أطعمه لأهلك " وليس فيه دليل على أن من عجز عن الكفارة أنها تسقط عنه؛ لأن هذا كفر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والكفارة كغيرها من الديون لا تسقط بالعجز إلا بإسقاط رب العالمين.
298- من المفطرات ما تكون سبباً في إضعاف قوة البدن وهي:
- 1- القيء عمداً.
- 2- الحجامة، وأما الحاجم؛ لأنه يمص الدم.
304- صيام داود أفضل الصيام بشرط ألا يضعفه ولا يشغله عما هو أهم، ولهذا في رواية البخاري " وكان لا يفر إذا لاقى ".
307- يستحب الوتر أول الليل في صورتين:
- 1- إذا غلب على ظنه عدم القيام آخر الليل.
- 2- في القيام في رمضان، فالأفضل متابعة الإمام والوتر معه.
315- في قوله تعالى (أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود).
قدَّم الطواف؛ لأنه لا يصح إلا في المسجد الحرام فقط، ثم الاعتكاف؛ لأنه لا يصح إلا في مسجد، ثم الصلاة؛ لأنها تصح في كل مكان.
319- قيل يصح الاعتكاف لوقت يسير إذا نوى حتى لو ساعة، عند المشهور من المذهب، والصحيح أنه راجع للعُرف كيوم أو نصف يوم، وأما الشيء القليل جداً فلا يُسمَّى اعتكافاً.
327- لماذا أهل مكة إذا أرادوا العمرة يخرجون خارج الحرم ليحرموا، وأما في الحج فلا يلزمهم الإحرام من الحل؟
لأن أفعال العمرة كلها تقع في الحرم، فلزمه أن يخرج فيحرم من الحل، ليجمع فيها بين الحل والحرم، وأما أفعال الحج فبعضها في الحل وبعضها في الحرم، فجاز أن يحرم من بيته.
330- المُحرَّمات في الحج على أقسام:
-
1- مُحرَّمات على الرجال خاصة: المخيط، تغطية الرأس، الخف.
-
2- مُحرَّمات على النساء فقط: النقاب، القفازات.
-
3- على الرجل والمرأة: الطيب، وهما نوعان: الطيب المعروف، وأما الأشياء التي لها رائحة وليست طيب فلا بأس بها، كالهيل، والزنجبيل.
333- التلبية سُنَّة مُؤكدة عند الجمهور، وقيل بوجوبها وهو مذهب مالك.
335- شرط المَحرَم للمرأة أن يكون بالغاً عاقلاً.
338- مَن اضطر لفعل محضور جاز، وعليه فدية الأذى، يُخير بين شاة، أو صيام ثلاثة أيام، إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، تقريباً كيلو ونصف من الطعام.
354- هناك ركنان في الكعبة ليستا على قواعد إبراهيم لهذا لا نستلمهما، وبعض الحِجر من البيت؛ لأن قريش لما قصُرت النفقة عندهم لم يكملوا الحِجر داخل الكعبة، وكرهوا أن يجعلوا فيه مالاً حراماً تعظيماً له.
356- بعض أفعال الحج شُرعت للتذكر:
-
1- الرمل؛ لما جرى بين الصحابة والكفار.
-
2- السعي؛ لما جرى في قصة أم إسماعيل.
-
3- رمي الجمار؛ لما جرى في قصة إبراهيم في رجم الشيطان.
362- توفي الرسول صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه من الحج ببضعة وثمانين يوماً.
370- العبادات نوعان: مالية، وبدنية، فالمالية يجوز التوكيل فيها: كالزكاة، والذبح، والكفارات، وأما العبادات البدنية فلا تجوز الوكالة فيها، كالصلاة والصيام؛ لأن المقصود في البدنية أن يفعلها هو، وأما المالية فالمقصود إخراجها فقط.
371- الذبائح نوعان:
-
1- لا يجوز لصاحبها الانتفاع بها، ولا دفعها للغني، مثل: الكفارات، النذور، ما وجب في الإحرام، جميع أنواع الفدية.
-
2- يجب الصدقة منها، ويجوز لصاحبها الأكل منها، ويجوز دفع بعضها للغني، مثل: العقيقة، الأضحية، هدي التمتع والقِران.
374- الغُسْل للإحرام، مُستحب بالإجماع، ولذا أُمِر به مَن ليس أهلاً للاغتسال كالحائض.
384- أفعال يوم العيد: الرمي، ثم الطواف، ثم الحلق، ثم الذبح.
ولا يبدأ وقتها على الصحيح إلا بعد طلوع الشمس، إلا من له عذر كالضعفة فيدخل وقتهم بعد منتصف الليل.
391- من أسماء مزدلفة:
-
1- جمع؛ لأن الحجاج يجتمعون فيها.
-
2- مزدلفة؛ لأن الحجاج يزدلفون منها إلى منى.
-
3- المشعر الحرام؛ لأنها من المشاعر التي في الحرم، كما أن عرفة مشعر حلال؛ لأنها خارج الحرم.
394- مَن تجاوز ميقات، وسيمر بميقات آخر فلا حرج أن يُحرِم ِمن الآخر.
399- في حديث " البيعان بالخيار ".
قال السعدي: ويحق لمن أراد البيع والشراء أن يعتني بمثل هذا الحديث ويتأدب بآدابه فإنه من أعظم الأسباب للفوز في الدنيا والآخرة.
410- لفظ " الخبيث " يطلق على المُحرَّم، كما في قوله تعالى (ويُحرِّم عليهم الخبائث) ويطلق على الرديء، كما في قوله تعالى (ولا تيمّمّوا الخبيث منه تنفقون) وفي الحديث: " ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث " اجتمع الأمران.
وأما حديث " كسب الحجام خبيث " فالمراد به الرديء؛ لأنه في مقابلة ما يخرج من الدم، وليس بمحرم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره.
439- الرهن من عقود التوثيقات؛ كالضمان، والكفالة، وما صح بيعه صح رهنه من كل شيء، وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، كالوقف.
445- الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وقال بعضهم: هو خاص بهذه الأمة، والأمم السابقة كان عندهم الصدقة فقط.
449- في العطية لا يجوز العود فيها لحديث " العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه " رواه البخاري، إلا الأب؛ لحديث " إلا الأب فيما يعطيه لولده " رواه أحمد.
451- في تفضيل الأبناء على بعض في العطايا، على خلاف كالضرير، وطالب العلم المتفرغ، والصواب الجواز؛ لأنه لم يفضله إلا لهذا المعنى، والغالب أن بقية الأولاد يرضون.
468- إذا مات الإنسان تعلَّق في ماله أربعة حقوق:
-
1- التجهيز، كالدفن وما يتبع ذلك.
-
2- الديون التي لله، أو الآدميين.
-
3- الوصية بالثلث فما دونه.
-
4- حق الورثة.
470- حديث " حتى ما تجعله في في امرأتك " أي: فمها، ولا يجوز تشديد " فيَّ " لأنه من الأسماء الخمسة.
473- عيادة المرضى من المستحبات ولكن قد تقترن بها أحوال فتجب كالوالدين والأرحام.
481- موانع الإرث: اختلاف الدين، الرق، القتل، وأسبابه: الرحم، النكاح، الولاء.
491- التبتل نوعان:
-
1- مأمور به كما في قوله تعالى (وتبتل إليه تبتيلاً)، والمعنى: تفرغ للعبادة وأقبل عليها.
-
2- منهي عنه؛ ومعناه: الانقطاع عن الزواج بسبب العبادة.
514- الصداق، له أسماء: الصّداق، النِّحلة، الفريضة، المهر، العوض.
522- كل الدعوات مباحة في الأصل، ما لم يكن ثمَّ عارض، فتستحب إن كان فيها مصلحة، أو تكره إذا كان فيها مفسدة، وتحرم إن كان فيها منكر لا يقدر على إزالته.
526- الطلاق، الأصل فيه الكراهة، ويباح للحاجة، ويستحب للضرر، ويجب بالإيلاء وإذا فسد دين المرأة، ويحرم في حال الطلاق البدعي، كالطلاق في الحيض أو في طُهرٍ جامعها فيه.
529- مِن أحكام النفقات على النساء:
-
1- الناشز لا نفقة لها.
-
2- المطلقة البائن، إذا كانت حامل، فالنفقة للحمل.
539- الحادّة لا تستعمل الحناء على وجه الزينة، ويجوز لها ذلك من باب العلاج.
542- اللعان، هو: أيمان مكررة من الجانبين، ولا يكون إلا بين زوجين.
وإذا تم اللعان:
-
1- يسقط الحد عنه.
-
2- يسقط الحد عنها.
-
3- المفارقة المؤبدة.
-
4- انتفاء الولد إذا نفاه، فلا يلحقه نسبه.
557- حديث " ومن ادعى ما ليس له فليس منا ويتبوأ مقعده من النار" رواه مسلم، وللبخاري نحوه.
وهذا عام في كل شيء؛ في الأموال، والحقوق، والمراتب وغيرها.
وأعظم من ذلك أن يحلف كاذباً، ويدخل فيه من ادعى العلم وليس بعالم، والطب وليس بطبيب.
558- حديث " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ".
الحكمة في التحريم بالرضاع ظاهرة، فإنه لما تغذى بهذا اللبن نبت لحمه عليه، فكان كالنسب له، ولذا قالوا: الرضاع يغير الطباع، ولذا استحبوا اختيار المرضعة الحسنة.
562- كلام جميل عن وجوب الحجاب وأن الصحابة والسلف أجمعوا عليه، والرد على علماء مصر الذين تساهلوا فيه.
565- ألفاظ العربية قسمان:
-
1- يقصد معناه الذي دل عليه اللفظ، وهذا الغالب من ألفاظهم، وهي التي وضعت لها قواميس اللغة.
-
2- لا يقصدون معناه الذي دل عليه اللفظ، مثل " تربت يمينك، عقرى، حلقى".
567- الإشهاد أقسام:
-
1- لا يثبت إلا بأربعة شهود ذكور، وهو في حال الزنا.
-
2- لا يثبت إلا بثلاثة رجال وهو من ادعى الإعسار وقد عُرِف بالغنى.
-
3- لا يثبت إلا برجلين، كالسرقة.
-
4- لا يثبت إلا برجل وامرأتين كالأموال.
-
5-يثبت بشهادة امرأة واحدة وهي الإخبارات الدينية، كهلال رمضان، والرواية، والأشياء التي لا يطلع عليها إلا النساء كالرضاع.
568- العدالة شرط في الشاهد، والصحيح في ضبطها أنه من يرضى عند الناس، كما قال تعالى (ممن ترضون من الشهداء).
592- نبات الحرم مُحرّم إلا:
-
1- الإذخر.
-
2- ما أنبته الآدمي.
-
3- اليابس.
-
4- ما وُجد مُنفصلاً ولو كان رطباً.
601- الحدود هي: عقوبات مُقدرة شرعاً على معاصٍ، والحكمة منها: لتمنع الوقوع في مثلها.
604- ورد ذكر الحرابة لله ورسوله في موضعين من القرآن:
-
1- قطاع الطريق، قال تعالى (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً).
-
2- آكل الربا، قال تعالى (فأذنوا بحرب من الله ورسوله).
613- لا عبرة بإقرارات السكران، والرد على من أوقع طلاق السكران.
618- السرقة: أخذ مال من مالكه على وجه الاختفاء، ويشترط في القطع أن يكون المال المأخوذ من حرز مثله، ويختلف باختلاف الأوقات والبلدان، فيرجع للعرف.
621- في قطع يد السارق، قالوا: لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت.
625- أوجب الله القصاص حفظاً للأبدان، وأوجب قطع يد السارق حفظاً للأموال، وأوجب حد الخمر حفظاً للعقول.
628- في حد الخمر، كم يجلد؟ على خلاف؛ والصواب ينظر للمصلحة.
629- حديث: (لا يُجلد فوق عشرة أسواط إلا في حدٍ من حدود الله) متفق عليه.
المعنى على الصحيح: لا يُزاد على عشرة أسواط في التأديب في الأمور التي ليست على فعل محرم أو ترك واجب، كتأديب معلم الصبيان، وتأديب الرجل زوجته.
631- الأيمان، تأكيد الخبر أو الفعل بِذكرِ مُعظّم بحروف القسم، أو ما يقوم مقامها.
633- في قوله تعالى (ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا).
أي: لا تجعلوا الحلف بالله مانعاً لكم من فعل هذه الأعمال الصالحة، وليس معنى الآية كما يظن البعض أنه نهي عن كثرة اليمين بالله.
635- الكفارة في الحلف من خصائص هذه الأمة.
639- حديث " من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم ".
سُمَّيت بذلك " صبر " لأنه يصبر على نفسه على الإثم.
648- النذر؛ أصله مكروه، والوفاء به واجب، وهذا من غرائب العلم؛ لأن القاعدة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وهذه وسيلته مكروهة وفعله واجب.
657- حديث " لا يحكم أحدكم بين اثنين وهو غضبان " متفق عليه.
ويقاس على الغضب كل ما يَشغل فِكرِ القاضي مِن جوع أو همّ وغمّ.
671- كان الحنيذ منتشر عند الأولين لقلة القدور، ويستعملونه لجميع اللحوم، وهو المشوي على الحجارة المحماة.
681- التسمية على الصيد شرط، وتسقط سهواً على الصحيح.
681- صيد الطير يجوز ولو أكل منه؛ لأنه لا يتعلم إلا بالأكل، وأما حديث " فإن أكل فلا تأكل " فإنه يقصد الكلب ونحوه.
703- يحرم الحرير على الصغير والكبير " الذكور " ويجوز أربع أصابع تابع للثوب، ومَن اعتاد لبسه فإنه يورث عادات النساء.
713- يباح ستر الكعبة بالحرير، ولم يزل عمل الناس عليه، وأول من كساها عبد الملك بن مروان.
تمت الفوائد ولله الحمد
مواد آخرى من نفس القسم
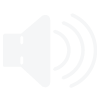 مكتبة الصوتيات
مكتبة الصوتيات
دار السعادة الأبدية
0:00
سعة رحمة الله
0:00
تلاوة من سورة التوبة
0:00
موت القلوب
0:00
الحث على التعلم والقراءة
0:00
عدد الزوار
7563824
إحصائيات |
مجموع الكتب : ( 46 ) كتاب |
مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم |
مجموع المقالات : ( 1728 ) مقال |
مجموع الصوتيات : ( 993 ) مادة |