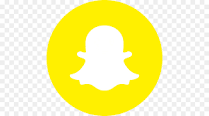كيف تستوي النعمة والبلاء عند المؤمن؟
هنا كلام جميل لابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج 2 / 525 مع حذف بعض الوجوه التي فيها تشابه.
قال: وإنَّما تستوي النِّعمة والبليَّة عنده في الرِّضا بهما لوجوهٍ:
أحدها: أنه مفوِّض، والمفوِّض راضٍ بكلِّ ما اختاره له مَن فوَّض إليه، ولا سيَّما إذا علم كمال حكمته ورحمته ولطفه وحسن اختياره له.
الثاني: أنّه جازمٌ بأنَّه لا تبديل لكلمات الله ولا رادَّ لحكمه، وأنَّه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فهو يعلم أنَّ كلًّا من البليَّة والنِّعمة بقضاءٍ سابقٍ وقدَرٍ حَتْم.
الثالث: أنَّه عبدٌ محض، والعبد المحض لا يتسخَّط جريان أحكام سيِّده المشفق البارِّ الناصح المحسن، بل يتلقَّاها كلَّها بالرضا به وعنه.
الرابع: أنَّه محبٌّ، والمحبُّ الصادق مَن رضي بما يعامله به حبيبه.
الخامس: أنَّه جاهلٌ بعواقب الأمور، وسيِّده أعلم بمصلحته وما ينفعه.
السادس: أنَّه لا يريد مصلحته من كلِّ وجهٍ ولو عرَفَ أسبابها، فهو جاهل ظالم، وربُّه تعالى يريد مصلحته ويسوق إليه أسبابها، ومِن أعظم أسبابها: ما يكرهه العبد، فإنَّ مصلحته فيما يكرهه أضعافُ مصلحته فيما يحبُّه. قال تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢١٦]. وقال تعالى: ﴿فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ١٩].
السابع: أنَّه مسلمٌ، والمسلم من قد سلَّم نفسه لله، ولم يعترض عليه في جريان أحكامه عليه، ولم يتسخط بذلك.
الثامن: أنَّه عارفٌ بربِّه حَسَنُ الظنِّ به، لا يتَّهمه فيما يجريه عليه من أقضيته وأقداره، فحُسن ظنِّه به يوجب له استواء الحالات عنده، ورضاه بما يختاره له سيِّده.
التّاسع: أنّه يعلم أنَّ حظَّه من المقدور ما يتلقَّاه به من رضًا أو سخطٍ، فلا بدَّ له منه، فإن رضي فله الرِّضا وإن سخط فله السخط.
العاشر: علمه بأنَّه إذا رضي به انقلب في حقِّه نعمةً ومنحةً، وخفَّ عليه حمله وأُعين عليه. وإذا سخطه تضاعف عليه ثقله وكَلُّه، ولم يزدد إلَّا شدَّة. فلو أنَّ السخط يجدي عليه شيئًا لكان له فيه راحة، فلا أنفع له من الرِّضا به. ونكتة المسألة: إيمانه بأنَّ قضاء الربِّ تعالى خيرٌ له، كما قال النبيُّ ﷺ: «والذي نفسي بيده، لا يقضي الله للمؤمن قضاءً إلَّا كان خيرًا له؛ إن أصابَتْه سرَّاءُ شكر فكان خيرًا له، وإن أصابته ضرَّاءُ صبر فكان خيرًا له، وليس ذلك إلَّا للمؤمن».
الحادي عشر: أن يعلم أنَّ تمام عبوديَّته في جريان ما يكرهه من الأحكام عليه. ولو لم يجر عليه منها إلَّا ما يحبُّ لكان أبعدَ شيءٍ عن عبوديَّة ربِّه. فلا تتمُّ له عبوديَّته من الصبر، والتوكُّل، والرِّضا، والتّضرُّع، والافتقار، والذُّلِّ، والخضوع، وغيرها إلَّا بجريان القدر له بما يكرهه. وليس الشأن في الرِّضا بالقضاء الملائم للطبيعة، إنَّما الشأن في الرضا بالقضاء المؤلم المنافر للطبع.
الثاني عشر: أن يعلم أنّ رضاه عن ربِّه في جميع الحالات يثمر له رضا ربِّه عنه، فإذا رضي عنه بالقليل من الرِّزق رضي ربُّه عنه بالقليل من العمل. وإذا رضي عنه في جميع الحالات واستوت عنده، وجده أسرع شيءٍ إلى رضاه إذا ترضَّاه وتملَّقه.
الثالث عشر: أن يعلم أنَّ أعظم راحته وسروره ونعيمه في الرِّضا عن ربِّه في جميع الحالات، فإنَّ الرِّضا باب الله الأعظم، ومستراح العارفين، وجنَّة الدُّنيا. فجديرٌ بمن نصح نفسه أن تشتدَّ رغبته فيه، ولا يستبدل بغيره منه.
الرابع عشر: أنَّ السخط باب الهمِّ والغمِّ والحزن، وشتات القلب، وكسف البال، وسوء الحال، والظنِّ بالله خلاف ما هو أهله. والرِّضا يخلِّصه من ذلك كلِّه ويفتح له باب جنَّة الدُّنيا قبل جنَّة الآخرة.
الخامس عشر: أنّ الرِّضا يفتح له باب السلامة، فيجعل قلبه سليمًا نقيًّا من الغشِّ والدَّغل والغلِّ. ولا ينجو من عذاب الله إلَّا من أتى الله بقلبٍ سليمٍ. وتستحيل سلامة القلب مع السخط وعدم الرِّضا. وكلَّما كان أشدَّ رضًا كان قلبه أسلم. فالخبث والدغل والغشُّ قرين السخط. وسلامةُ القلب وبرُّه ونصحه قرين الرِّضا. وكذلك الحسد هو من ثمرات السخط، وسلامةُ القلب منه من ثمرات الرِّضا.
السادس عشر: أن السخط يوجب تلوُّن العبد وعدمَ ثباته مع الله، فإنَّه لا يرضى إلَّا بما يلائم طبعه ونفسه. والمقادير تجري دائمًا بما يلائمه وبما لا يلائمه. وكلَّما جرى عليه منها ما لا يلائمه سخطه، فلا يثبت له على العبوديَّة قدم. فإذا رضي عن ربِّه في جميع الحالات استقرَّت قدمُه في مقام العبودية. فلا يزيل التلوُّن عن العبد شيءٌ مثل الرِّضا.
السابع عشر: أنَّ السخط يفتح عليه باب الشكِّ في الله وقضائه وقدره وحكمته وعلمه، فقلَّ أن سَلِم الساخط من شكٍّ يُداخل قلبه ويتغلغل فيه، وإن كان لا يشعر به. فلو فتَّش غاية التفتيش لوجد يقينه معلولًا مدخولًا، فإنَّ الرِّضا واليقين أخوان مصطحبان، والشكُّ والسخط قرينان. وهذا معنى الحديث الذي في الترمذي أو غيره: إن استطعت أن تعمل لله بالرِّضا مع اليقين فافعل، فإن لم تستطع فإنَّ في الصبر على ما تكره خيرًا كثيرًا.
الثامن عشر: أنّ الرِّضا بالمقدور من سعادة ابن آدم، وسخطُه من شقاوته، كما في المسند والترمذي من حديث سعد بن أبي وقَّاص قال: قال رسول الله ﷺ: مِن سعادة ابن آدم استخارةُ الله عز وجل، ومن سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله. ومن شِقوة ابن آدم سخطه بما قضى الله، ومن شقاوة ابن آدم تركُ استخارة الله.
فالرِّضا بالقضاء من أسباب السعادة، والتسخُّط على القضاء من أسباب الشقاوة.
التاسع عشر: أنَّ الشّيطان إنَّما يظفر بالإنسان غالبًا عند السخط والشهوة، فهناك يصطاده. ولا سيَّما إذا استحكم سخطه، فإنَّه يقول ما لا يرضي الربَّ، ويفعل ما لا يرضيه، وينوي ما لا يرضيه.
ولهذا قال النبيُّ ﷺ عند موت ابنه إبراهيم: « يحزن القلب، وتدمع العين، ولا نقول إلا ما يُرضي الربّ »، فإنَّ موت البنين من العوارض التي توجب للعبد التسخُّط على القدر، فأخبر ﷺ أنَّه لا يقول في مثل هذا المقام الذي يسخطه أكثر الناس، فيتكلَّمون بما لا يرضي الله عز وجل، ويفعلون ما لا يرضيه إلَّا ما يرضي ربَّه تبارك وتعالى.
ولهذا لمَّا مات ابن الفضيل بن عياضٍ رُئي في الجنازة ضاحكًا، فقيل له: تضحك وقد مات ابنك؟ فقال: إنَّ الله قضى بقضاءٍ فأحببتُ أن أرضى بقضائه.
فأنكرت طائفةٌ هذا على الفضيل، وقالوا: رسول الله ﷺ قد بكى يوم موت ابنه، وأخبر أنَّ القلب يحزن والعين تدمع، وهو في أعلى مقامات الرِّضا. فكيف يعدُّ هذا في مناقب الفضيل؟
والتحقيق: أن قلب رسول الله ﷺ اتَّسع لتكميل المراتب من الرِّضا عن الله والبكاء رحمةً للصبي، فكان له مقام الرِّضا ومقام الرحمة ورقَّة القلب. والفضيل لم يتَّسع لذلك، فغيَّبه مقام الرضا عن مقام الرحمة، فلم يجتمع له الأمران. والناس في ذلك على أربع مراتب.
أحدها: من اجتمع له الرِّضا بالقضاء ورحمة الطِّفل، فدمعت عيناه رحمةً والقلبُ راضٍ.
الثاني: من غيَّبه الرِّضا عن الرحمة، فلم يتَّسع للأمرين.
الثالث: من غيَّبته الرحمة والرقَّة عن الرِّضا فلم يشهده.
الرابع: من لا رضا عنده ولا رحمة، وإنَّما كان حزنُه لفوات حظِّه من الميِّت. وهذا حال أكثر الخلق. فلا إحسان ولا رضا عن الرحمن. والله المستعان.
العشرون: أنَّ الرِّضا هو اختيار ما اختاره الله لعبده. والسخط كراهة ما اختاره الله، وهذا نوع محادَّة، فلا يتخلَّص منه إلا بالرِّضا عن الله في جميع الحالات.
الواحد والعشرون: أنَّ الرِّضا بالقضاء أشقُّ شيءٍ على النفس. بل هو ذبحها في الحقيقة، فإنَّه مخالفة هواها وطبعها وإرادتها. ولا تصير مطمئنَّةً قطُّ حتى ترضى بالقضاء، فحينئذٍ تستحقُّ أن يقال لها: ﴿يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ - ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً - فَادْخُلِي فِي عِبَادِي - وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾ [الفجر: ٢٧ - ٣٠].
الثاني والعشرون: أنَّ كلَّ قدرٍ يكرهه العبد ولا يلائمه لا يخلو أن يكون عقوبةً على ذنب، فهو دواءٌ لمرضٍ لولا تدارك الحكيم إيَّاه بالدواء لترامى بالمريض إلى الهلاك، أو يكونَ سببًا لنعمةٍ لا تُنال إلَّا بذاك المكروه، فالمكروه ينقطع ويتلاشى، وما ترتَّب عليه من النِّعمة دائمٌ لا ينقطع، فإذا شهد العبد هذين الأمرين انفتح له باب الرِّضا عن ربِّه في كلِّ ما يقضيه ويقدِّره.
مواد آخرى من نفس القسم
 مكتبة الصوتيات
مكتبة الصوتيات
عجائب الاستغفار
0:00
قصة قارون
0:00
التنويع في العبادات
0:00
معالم تربوية حول المال
0:00
الرضا بالقدر
0:00
عدد الزوار
7430412
إحصائيات |
مجموع الكتب : ( 44 ) كتاب |
مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم |
مجموع المقالات : ( 1713 ) مقال |
مجموع الصوتيات : ( 992 ) مادة |