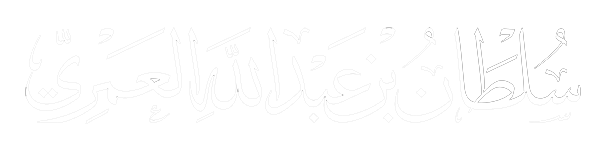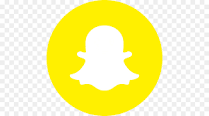قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعاد 1 / 464:
وفضلُ العلم على المال يُعْلَمُ من وجوه:
أحدها: أنَّ العلمَ ميراثُ الأنبياء، والمالُ ميراثُ الملوك والأغنياء.
الثاني: أنَّ العلمَ يحرسُ صاحبَه، وصاحبُ المال يحرسُ مالَه.
والثالث: أنَّ المالَ تُذْهِبُه النفقات، والعلمُ يزكو على النفقة.
الرابع: أنَّ صاحبَ المال إذا مات فارقه مالُه، والعلمُ يدخلُ معه قبرَه.
الخامس: أنَّ العلمَ حاكمٌ على المال، والمالُ لا يحكمُ على العلم.
السادس: أنَّ المالَ يحصُل للمؤمن والكافر والبَرِّ والفاجر، والعلمُ النافعُ لا يحصُل إلا للمؤمن.
السابع: أنَّ العالِمَ يحتاجُ إليه الملوكُ فمن دونهم، وصاحبُ المال إنما يحتاجُ إليه أهلُ العُدْم والفاقة.
الثامن: أنَّ النفسَ تَشْرُفُ وتزكو بجمع العلم وتحصيله، وذلك من كمالها وشرفها، والمالُ لا يزكِّيها ولا يكمِّلها ولا يزيدُها صفةَ كمال، بل النفسُ تنقصُ وتَشِحُّ وتبخلُ بجمعه والحرص عليه؛ فحرصُها على العلم عينُ كمالها، وحرصُها على المال عينُ نقصها.
التاسع: أنَّ المالَ يدعوها إلى الطغيان والفخر والخيلاء، والعلمُ يدعوها إلى التواضع والقيام بالعبودية؛ فالمالُ يدعوها إلى صفات الملوك والعلمُ يدعوها إلى صفات العبيد.
العاشر: أنَّ العلمَ حاجبٌ موصلٌ لها إلى سعادتها التي خُلِقَت لها والمال حجابٌ عنها وبينها .
الحادي عشر: أنَّ غِنى العلم أجلُّ من غِنى المال؛ فإنَّ غِنى المال غِنًى بأمرٍ خارجيٍّ عن حقيقة الإنسان، لو ذهبَ في ليلةٍ أصبح فقيرًا مُعْدِمًا، وغِنى العلم لا يُخشى عليه الفقر، بل هو في زيادةٍ أبدًا، فهو الغِنى العالي حقيقة؛ كما قيل:
غَنِيتُ بلا مالٍ عن الناس كلِّهم وإنَّ الغِنى العالي عن الشَّيء لا به
الثاني عشر: أنَّ المال يَسْتَعْبِدُ مُحِبَّه وصاحبه، فيجعلُه عبدًا له، كما قال النبيُّ ﷺ: " تَعِسَ عبد الدينار والدرهم " الحديث، والعلمُ يَسْتَعْبِدُه لربِّه وخالقه، فهو لا يدعوه إلا إلى عبوديَّة الله وحده.
الثالث عشر: أنَّ حبَّ العلم وطلبَه أصلُ كلِّ طاعة، وحبَّ الدنيا والمال وطلبه أصلُ كلِّ سيئة .
الرابع عشر: أنَّ قيمةَ الغنيِّ مالُه، وقيمةَ العالِم علمُه، فهذا متقوِّمٌ بماله، فإذا عُدِمَ مالُه عُدِمَت قيمتُه فبقي بلا قيمة، والعالِمُ لا تزولُ قيمتُه، بل هي في تضاعفٍ وزيادةٍ دائمًا.
الخامس عشر: أنَّ جوهرَ المال من جنس جوهر البدن، وجوهرُ العلم من جنس جوهر الروح، كما قال يونس بن حبيب: " علمُك من روحك، ومالُك من بدنك " والفرقُ بين الأمرين كالفرق بين الروح والبدن.
السادس عشر: أنَّ العالِم لو عُرِضَ عليه بحظِّه من العلم الدنيا بما فيها لم يَرْضَها عِوَضًا من علمه، والغنيُّ العاقلُ إذا رأى شرفَ العالِم وفضلَه وابتهاجَه بالعلم وكمالَه به يودُّ لو أنَّ له علمَه بغناه أجمع.
السابع عشر: أنَّ ما أطاع اللهَ أحدٌ قطُّ إلا بالعلم، وعامةُ من يعصيه إنما يعصيه بالمال.
الثامن عشر: أنَّ العالِمَ يدعو الناسَ إلى الله بعلمه وحاله، وجامعُ المال يدعوهم إلى الدنيا بحاله وماله.
التاسع عشر: أنَّ غِنى المال قد يكونُ سببَ هلاك صاحبه كثيرًا؛ فإنه معشوقُ النفوس، فإذا رأت من يستأثرُ بمعشوقها عليها سعت في هلاكه، كما هو الواقع. وأمَّا غِنى العلم فسببُ حياة الرجل وحياة غيره به، والناسُ إذا رأوا من يستأثرُ عليهم به ويطلبُه أحبُّوه وخدموه وأكرموه.
العشرون: أنَّ اللذَّةَ الحاصلةَ من غِنى المال إما لذَّةٌ وهميَّة وإما لذَّةٌ بهيميَّة، فإنَّ صاحبه إنْ التذَّ بنفس جمعه وتحصيله فتلك لذَّةٌ وهميَّةٌ خياليَّة وإن التذَّ بإنفاقه في شهواته فهي لذَّةٌ بهيميَّة، وأمَّا لذَّةُ العلم فلذَّةٌ عقليَّةٌ روحانيَّة، وهي تشبهُ لذَّة الملائكة وبهجتَها، وفرقٌ ما بين اللذَّتين.
الحادي والعشرون: أنَّ عقلاء الأمم مطبقون على ذمِّ الشَّرِه في جمع المال الحريصِ عليه، وتنقُّصِه والإزراء به، ومطبقون على تعظيم الشَّرِه في جمع العلم وتحصيله، ومدحِه ومحبَّته ورؤيته بعين الكمال.
الثاني والعشرون: أنهم مطبقون على تعظيم الزاهد في المال، المُعْرِض عن جمعه، الذي لا يَلْتَفِتُ إليه ولا يجعلُ قلبَه عبدًا له، ومطبقون على ذمِّ الزاهد في العلم، الذي لا يلتفتُ إليه ولا يحرصُ عليه.
الثالث والعشرون: أنَّ المال إنما يُمْدَحُ صاحبُه بتخلِّيه منه وإخراجه، والعلمُ إنما يُمْدَحُ بتحلِّيه به واتِّصافه به.
الرابع والعشرون: أنَّ غِنى المال مقرونٌ بالخوف والحزن، فهو حزينٌ قبل حصوله، خائفٌ بعد حصوله، وكلَّما كان أكثر كان الخوفُ أقوى، وغِنى العلم مقرونٌ بالأمن والفرح والسرور.
الخامس والعشرون: أنَّ الغنيَّ بماله لا بدَّ أن يفارقَه غِناه، فيتعذَّبَ ويتألم بمفارقته، والغِنى بالعلم لا يزول، فلا يتعذَّبُ صاحبُه ولا يتألم؛ فلذَّةُ الغِنى بالمال لذَّةٌ زائلةٌ منقطعةٌ يَعْقُبُها الألم، ولذَّةُ الغِنى بالعلم لذَّةٌ باقيةٌ مستمرةٌ لا يلحقها ألم.
السادس والعشرون: أنَّ استلذاذ النفس وكمالَها بالغِنى استكمالٌ بعاريَّةٍ مؤدَّاة، فتجمُّلها بالمال تجمُّلٌ بثوبٍ مستعارٍ لا بدَّ أن يرجع إلى مالكه يومًا ما، وأما تجمُّلها بالعلم وكمالُها به فتجمُّلٌ بصفةٍ ثابتةٍ لها راسخةٍ فيها لا تفارقُها.
السابع والعشرون: أنَّ الغِنى بالمال هو عينُ فقر النفس، والغِنى بالعلم فهو غِناها الحقيقي؛ فغِناها بعلمها هو الغِنى، وغِناها بمالها هو الفقر.
الثامن والعشرون: أنَّ من قُدِّم وأُكرِم لماله إذا زال مالُه ذهب تقديمُه وإكرامُه، ومن قُدِّم وأُكرِم لعلمه فإنه لا يزدادُ إلا تقديمًا وإكرامًا.
التاسع والعشرون: أنَّ تقديمَ الرجل لماله هو عينُ ذمِّه؛ فإنه نداءٌ عليه بنقصه، وأنه لولا ماله لكان مستحقًّا للتأخير والإهانة ، وأما تقديمُه وإكرامُه لعلمه فإنه عينُ كماله؛ إذ هو تقديمٌ له بنفسه وبصفته القائمة به، لا بأمرٍ خارجٍ عن ذاته.
الوجه الثلاثون: أنَّ طالبَ الكمال بغِنى المال كالجامع بين الضدَّين؛ فهو طالبٌ ما لا سبيل له إليه.
وبيانُ ذلك: أنَّ القدرةَ صفةُ كمال، وصفةُ الكمال محبوبةٌ بالذَّات، والاستغناءُ عن الغير ــ أيضًا ــ صفةُ كمالٍ محبوبةٌ بالذَّات، فإذا مال الرجلُ بطبعه إلى السَّخاوة والجُود وفِعْل المَكْرُمات، فهذا كمالٌ مطلوبٌ للعقلاء، محبوبٌ للنفوس، وإذا التفتَ إلى أنَّ ذلك يقتضي خروجَ المال من يده، وذلك يُوجِبُ نقصَه واحتياجَه إلى غيره وزوالَ قدرته نَفَرَت نفسُه عن السَّخاء والكرم والجُود واصطناع المعروف، وظنَّ أنَّ كماله في إمساك المال.
وهذه البليَّةُ أمرٌ ثابتٌ لعامَّة الخَلق، لا ينفكُّون عنها .
فلأجل مَيْل الطَّبع إلى حصول المدح والثناء والتعظي يحبُّ الجودَ والسَّخاءَ والمكارم، ولأجل فَوْتِ القدرة الحاصلة بسبب إخراجه والحاجة المنافية لكمال الغنى يحبُّ إبقاءَ ماله، ويكره السَّخاءَ والكرمَ والجود.
فيبقى قلبُه واقفًا بين هذين الدَّاعِيَين يتجاذبانه، ويَعْتَوِرَان عليه، فيبقى القلبُ في مقام المعارضة بينهما، فمن الناس من يترجَّحُ عنده جانبُ البذل والجود والكرم، فيُؤثِرُه على الجانب الآخر، ومنهم من يترجَّحُ عنده جانبُ الإمساك وبقاء القدرة والغِنى، فيُؤثِرُه.
فهذان نَظَران للعقلاء.
ومنهم من يبلغُ به الجهلُ والحماقةُ إلى حيث يريدُ الجمعَ بين الوجهين، فيَعِدُ الناسَ بالجود والسَّخاء والمكارم؛ طمعًا منه في فوزه بالمدح والثناء على ذلك، وعند حضور الوقت لا يَفِي بما قال؛ فيَسْخُو ويبذلُ بلسانه، ويُمْسِكُ بقلبه ويده؛ فيقعُ في أنواعٍ من القبائح والفضائح!
وإذا تأمَّلتَ أحوال أهل الدنيا من الأغنياء رأيتهم تحت أسْر هذه البليَّة وهم غالبًا يَشْكُونَ ويَبْكُون.
وأما غنيُّ العلم، فلا يَعْرِضُ له شيءٌ من ذلك، بل كلَّما بَذَله ازداد ببذله فرحًا وسرورًا وابتهاجًا، والعالِمُ وإن فاتتهُ لذَّةُ أهل الغِنى وتمتُّعهم بأموالهم فهم أيضًا قد فاتتهم لذَّةُ أهل العلم وتمتُّعهم بعلومهم وابتهاجُهم بها.
فمع صاحب العلم من أسباب اللذَّة ما هو أعظمُ وأقوى وأدومُ من لذَّة الغني، وتعبُه في تحصيله وجمعه وضبطه أقلُّ من تعب جامع المال بجمعه وألمُه دون ألمِه؛ كما قال تعالى للمؤمنين ــ تسليةً لهم بما ينالُهم من الألم والتعب في طاعته ومرضاته ــ: ﴿وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ١٠٤].
الحادي والثلاثون: أنَّ اللذَّة الحاصلة من المال والغِنى إنما هي حالَ تجدُّده فقط، وأما حالَ دوامه: فإما أن تذهبَ تلك اللذَّة، وإمَّا أن تنقُص.
ويدلُّ عليه أنَّ الطَّبعَ يبقى طالبًا لغِنًى آخر، حريصًا عليه، فهو يحاولُ تحصيلَ الزيادة دائمًا، فهو في فقرٍ مستمرٍّ غير مُنْقَضٍ ، ولو ملكَ خزائنَ الأرض ففقرُه وطلبُه وحرصُه باقٍ عليه؛ فإنه أحدُ المنهومَيْن اللذَين لا يشبعان ، فهو لا يفارقُه ألمُ الحرص والطَّلب.
وهذا بخلاف غنيِّ العلم والإيمان؛ فإنَّ لذَّتَه في حال بقائه مثلُها في حال تجدُّده، بل أزْيَد، وصاحبُها وإن كان لا يزالُ طالبًا للمزيد حريصًا عليه، فطلبُه وحرصُه مُسْتَصْحِبٌ للذَّة الحاصل، ولذَّة المرجوِّ المطلوب، ولذَّة الطَّلب وابتهاجه وفرحه به.
الثاني والثلاثون: أنَّ غِنى المال يستدعي الإنعامَ على الناس والإحسانَ إليهم؛ فصاحبُه إما أن يسُدَّ على نفسه هذا الباب، وإما أن يفتحه عليه.
فإن سدَّه على نفسه اشتُهِرَ عند الناس بالبعد من الخير والنفع؛ فأبغضوه وذمُّوه واحتقروه، وكلُّ من كان بغيضًا عند الناس حقيرًا لديهم كان وصولُ الآفات والمضرَّات إليه أسرعَ من النار في الحطب اليابس، ومن السَّيل في مُنْحَدَره، وإذا عرفَ من الخلق أنهم يمقتونه ويبغضونه ولا يقيمون له وزنًا تألَّم قلبُه غايةَ التألم، وأُحْضِرَ الهمومَ والغمومَ والأحزان.
وإن فتحَ باب الإحسان والعطاء فإنه لا يمكنُه إيصالُ الخير والإحسان إلى كلِّ أحد، فلا بدَّ من إيصاله إلى البعض وإمساكه عن البعض، وهذا يفتحُ عليه باب العداوة والمذمَّة من المحروم والمرحوم.
أمَّا المحرومُ فيقول: كيف جادَ على غيري وبَخِل عليَّ؟!
وأمَّا المرحومُ فإنه يلتذُّ ويفرحُ بما حصلَ له من الخير والنفع، فيبقى طامعًا مُسْتَشْرِفًا لنظيره على الدوام، وهذا قد يتعذَّرُ غالبًا؛ فيفضي ذلك إلى العداوة الشديدة والمذمَّة، ولهذا قيل: اتقِ شرَّ من أحسنتَ إليه.
وهذه الآفاتُ لا تعرضُ في غِنى العلم؛ فإنَّ صاحبَه يمكنُه بذلُه للعالَم واشتراكُهم فيه ، والقدرُ المبذولُ منه باقٍ لآخذه لا يزول، بل يتَّجِرُ به، فهو
كالغنيِّ إذا أعطى الفقيرَ رأسَ مالٍ يتَّجِرُ به حتى يصير غنيًّا مثلَه.
الوجه الثالث والثلاثون: أنَّ جمعَ المال مقرونٌ بثلاثة أنواعٍ من الآفات والمِحَن: نوعٌ قبله، ونوعٌ عند حصوله، ونوعٌ بعد مفارقته.
* فأما النوعُ الأول: فهو المشاقُّ والأنكادُ والآلامُ التي لا يحصلُ إلا بها.
* وأما النوعُ الثاني: فمشقَّةُ حفظه وحراسته وتعلُّق القلب به، فلا يُصْبِحُ إلا مهمومًا، ولا يمسي إلا مغمومًا.
فهو بمنزلة عاشقٍ مُفْرِط المحبَّة قد ظَفِر بمعشوقه، والعيونُ من كلِّ جانبٍ ترمقُه، والألسنُ والقلوبُ ترشقُه، فأيُّ عَيْشٍ وأيُّ لذَّةٍ لمن هذه حالُه؟! وقد عَلِمَ أنَّ أعداءه وحسَّادَه لا يفتُرون عن سعيهم في التفريق بينه وبين معشوقه وإن لم يظفروا هم به، ولكنَّ مقصودَهم أن يزيلوا اختصاصَه به دونهم، فإن فازوا به وإلا استووا في الحرمان، فزال الاختصاصُ المُؤْلِمُ للنفوس.
ولو قدروا على مثل ذلك مع العالِم لفعلوه، ولكنَّهم لما علموا أنه لا سبيل إلى سَلْبِه علمَه عمدوا إلى جحده وإنكاره؛ ليزيلوا من القلوب محبَّته وتقديمَه والثناءَ عليه، فإن بَهَرَ علمُه وامتنع عن مكابرة الجحود والإنكار رَمَوه بالعظائم، ونسبوه إلى كلِّ قبيح؛ ليزيلوا من القلوب محبَّته ويُسْكِنوا موضعَها النُّفرة عنه وبغضَه. وهذا شغلُ السَّحرة بعينه؛ فهؤلاء سحرةٌ بألسنتهم.
فإن عجزوا له عن شيءٍ من القبائح الظاهرة بعينه رَمَوه بالتلبيس والتدليس، والزَّوْكَرة والرِّياء، وحبِّ الترفُّع وطلب الجاه.
وهذا القَدْرُ من معاداة أهل الجهل والظُّلم للعلماء مثلُ الحرِّ والبرد لا بدَّ منه، فلا ينبغي لمن له مُسْكةُ عقلٍ أن يتأذَّى به؛ إذ لا سبيل له إلى دفعه بحال، فليوطِّن نفسَه عليه كما يوطِّنُها على برد الشتاء وحرِّ الصَّيف.
* والنوعُ الثالث من آفات الغِنى: ما يحصلُ للعبد بعد مفارقته من تعلُّق قلبه به، وكونه قد حِيل بينه وبينه، والمطالبة بحقوقه، والمحاسبة على مقبوضه ومصروفه: من أين اكتسبه وفي ماذا أنفقه؟
وغِنى العلم والإيمان مع سلامته من هذه الآفات فهو كفيلٌ بكلِّ لذَّةٍ وفرحةٍ وسرور، ولكن لا يُنالُ إلا على جسرٍ من التعب والصبر والمشقَّة.
الرابع والثلاثون: أنَّ لذَّةَ الغنيِّ بالمال مقرونةٌ بخُلْطَة الناس، ولو لم يكن إلا خَدَمُه وأزواجُه وسَراريه وأتباعُه؛ إذ لو انفردَ الغنيُّ بماله وحده من غير أن يتعلَّق بخادمٍ أو زوجةٍ أو أحدٍ من الناس لم يَكْمُل انتفاعُه بماله، ولا التذاذُه به.
وإذا كان كمالُ لذَّته بغناه موقوفًا على اتصاله بالغير، فذلك الاتصالُ منشأُ الآفات والآلام وأنواع النَّكد، ولو لم يكن إلا اختلافُ أخلاق الناس وطبائعهم وإراداتهم؛ فقبيحُ هذا حسنُ ذاك، ومصلحةُ ذاك مفسدةُ هذا، ومنفعةُ هذا مضرَّةُ الآخر، وبالعكس؛ فهو مبتلىً بهم، فلا بدَّ من وقوع النُّفرة والتباغض والتعادي بينهم وبينه؛ فإنَّ إرضاءهم كلِّهم محال، وهو جمعٌ بين الضدَّين، وإرضاءُ بعضهم وإسخاطُ غيره سببُ الشرِّ والمعاداة.
وكلما طالت المخالطةُ ازدادت أسبابُ الشرِّ والعداوة وقَوِيَت؛ وبهذا السَّبب كان الشرُّ الحاصلُ من الأقارب والعُشَراء أضعاف الشرِّ الحاصل من الأجانب والبُعَداء.
وهذه المخالطةُ إنما حصلت من جانب الغِنى بالمال، أما إذا لم يكن فيه فضيلةٌ لهم فإنهم يتجنَّبون مخالطتَه ومعاشرتَه، فيستريح من أذى الخُلْطة والعِشْرة.
وهذه الآفاتُ معدومةٌ في الغِنى بالعلم.
الخامس والثلاثون: أنَّ المالَ لا يرادُ لذاته وعَيْنه؛ فإنه لا يحصُل بذاته شيءٌ من المنافع أصلًا؛ فإنه لا يُشْبِعُ ولا يُرْوِي، ولا يُدْفِاءُ ولا يُمْتِع، وإنما يرادُ لهذه الأشياء؛ فإنه لما كان طريقًا إليها أريدَ إرادةَ الوسائل، ومعلومٌ أنَّ الغايات أشرفُ من الوسائل؛ فهذه الغاياتُ إذًا أشرفُ منه، وهي مع شرفها بالنسبة إليه ناقصةٌ دنيَّة.
وقد ذهب كثيرٌ من العقلاء إلى أنها لا حقيقةَ لها، وإنما هي دفعُ آلامٍ فقط فإنَّ لبسَ الثِّياب ــ مثلًا ــ إنما فائدتُه دفعُ التألم بالحرِّ والبرد والريح، وليس فيها لذَّةٌ زائدةٌ على ذلك، وكذلك الأكلُ إنما فائدتُه دفعُ ألم الجوع، ولهذا لو لم يجد ألمَ الجوع لم يَسْتَطِب الأكل، وكذلك الشربُ مع العطش، والراحةُ مع التعب.
ومعلومٌ أنَّ في مزاولة ذلك وتحصيله ألم وضرر ، ولكنَّ ضررَه وألمَه أقلُّ من ضرر ما يُدْفَعُ به وألمِه، فيحتملُ الإنسانُ أخفَّ الضَّررين دفعًا لأعظمهما.
وحُكِي عن بعض العقلاء أنه قيل له ــ وقد تناول قدحًا كريهًا جدًّا من الدواء ــ: كيف حالك معه؟ قال:
أصبحتُ في دارِ بَلِيَّاتِ أدفعُ آفاتٍ بآفات
السادس والثلاثون: أنَّ غنيَّ المال يبغضُ الموتَ ولقاءَ الله؛ فإنَّه لحبِّه مالَه يكرهُ مفارقتَه ويحبُّ بقاءه ليتمتَّع به، كما يشهدُ به الواقع.
وأمَّا العلمُ، فإنه يحبِّبُ للعبد لقاءَ ربِّه، ويزهِّدُه في هذه الحياة النَّكِدَة الفانية.
السابع والثلاثون: أنَّ الأغنياء يموتُ ذكرُهم بموتهم، والعلماءُ يموتون ويحيا ذكرُهم؛ كما قال أميرُ المؤمنين في هذا الحديث: " مات خُزَّانُ الأموال وهم أحياء، والعلماءُ باقون ما بقي الدهر " ؛ فخُزَّانُ الأموال أحياءٌ كأموات، والعلماءُ بعد موتهم أمواتٌ كأحياء.
الثامن والثلاثون: أنَّ نسبةَ العلم إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن؛ فالروحُ ميتةٌ حياتُها بالعلم، كما أنَّ الجسدَ ميتٌ حياتُه بالروح، فالغِنى بالمال غايتُه أن يزيد في حياة البدن، وأمَّا العلمُ فهو حياةُ القلوب والأرواح، كما تقدم تقريرُه.
التاسع والثلاثون: أنَّ القلبَ مَلِكُ البدن، والعلمَ زينتُه وعُدَّتُه ومالُه، وبه
قِوامُ مُلْكه، والمَلِكُ لا بدَّ له من عددٍ وعُدَّةٍ ومالٍ وزينة؛ فالعلمُ هو مركبُه وعدَّتُه وجَمالُه .
وأمَّا المالُ فغايتُه أن يكون زينةً وجَمالًا للبدن إذا أنفقه في ذلك، فإذا خَزَنَه ولم ينفقه لم يكن زينةً ولا جمالًا، بل نقصًا ووبالًا.
ومن المعلوم أنَّ زينةَ المَلِك وما به قِوامُ ملكه أجلُّ وأفضلُ من زينة رعيَّته وجَمالهم، فقِوامُ القلب بالعلم، كما أنَّ قِوامَ الجسم بالغذاء.
الوجه الأربعون: أنَّ القدرَ المقصودَ من المال هو ما يكفي العبد ويُقِيمُه ويدفعُ ضرورتَه حتى يتمكَّن من قضاء جَهازه ومن التزوُّد لسفره إلى ربِّه فإذا زاد على ذلك شَغَلَه وقَطَعَه عن السفر إلى ربِّه وعن قضاء جَهازه وتَعْبِيَة زاده؛ فكان ضررُه عليه أكثر من مصلحته، وكلَّما ازدادَ غِناه به ازدادَ تثبُّطًا وتخلُّفًا عن التجهُّز لما أمامه.
وأمَّا العلمُ النافع، فكلَّما ازدادَ منه ازدادَ في تَعْبِيَة الزاد، وقضاء الجَهاز، وإعداد عدَّة المسير، والله الموفِّق وبه الاستعانة، ولا حول ولا قوة إلا به.
فعُدَّةُ هذا السفر هو العلمُ والعمل، وعُدَّةُ الإقامة جمعُ الأموال والادِّخار، ومن أراد شيئًا هيَّأ له عُدَّتَه، قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ﴾ [التوبة: ٤٦].
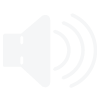 مكتبة الصوتيات
مكتبة الصوتيات
سعة رحمة الله
0:00
أرض المحشر
0:00
تأملات من سورة الزخرف - 1
0:00
باب صلاة الجماعة من كتاب عمدة الأحكام
0:00
من أسباب الطلاق عند الرجال - 2
0:00
عدد الزوار
7395473
إحصائيات |
مجموع الكتب : ( 44 ) كتاب |
مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم |
مجموع المقالات : ( 1710 ) مقال |
مجموع الصوتيات : ( 992 ) مادة |