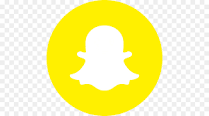فوائد من كتاب فتح الرحمن بكشف مايلتبس في القرآن
تأليف الإمام أبي زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى
- قوله تعالى: ( اهدنا الصراط المستقيم ) .
إن قلت: المراد " بالصراط المستقيم " الإسلام، أو القرآن، أو طريق الجنة كما قيل ، والمؤمنون مهتدون إلى ذلك، فما معنى طلب الهداية له ، إذ فيه تحصيل الحاصل ؟
قلت : معناه ثبتنا وأدمنا عليه مع الاستقامة كما في قوله ( يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ) .
- قوله تعالى: ( فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ) .
فإن قلت: ما فائدة ذكر اليد، مع أن الكتابة لا تكون إلا بها ؟
قلت: فائدته تحقيق مباشرتهم ما حرفوه بأنفسهم ، زيادة في تقبيح فعلهم.
- قوله تعالى: ( وما كان الله ليضيع إيمانكم ) .
كان " للماضي وهو هنا للحال، وتأتي في القرآن لخمسة معان:
أ - للحال ومنه " إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " و " كان الله بما يعملون بصيرا ".
ب - وللماضي المنقطع ومنه " وكان في المدينة تسعة رهط " وهو الأصل في معانيها.
ب - وللاستقبال ومنه " ويخافون يوما كان شره مستطيرا ".
د - وللدوام ومنه " وكان الله عليما حكيما ".
هـ - وبمعنى صار ومنه " وكان من الكافرين ".
- قوله تعالى: ( ولا يكلمهم الله يوم القيامة ) .
إن قلت: كيف نفى عنهم الكلام هنا وأثبته لهم في قوله " فوربك لنسألنهم " ؟
قلت : النفي هنا الكلام بلطف وإكرام ، والمثبت ثم سؤال توبيخ وإهانة، أو في القيامة مواقف ، ففي موقف لا يكلمهم ، وفي موقف يكلمهم.
ومن ذلك آية النفي المذكورة ، مع قوله تعالى " ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ".
- قوله تعالى: ( تلك حدود الله فلا تقربوها ) .
إن قلت: لم قال هنا " فلا تقربوها " وقال في التي بعدها " فلا تعتدوها "؟.
قلت: لأن الحد هنا نهي وهو قوله " ولا تباشروهن " وما كان من الحدود نهيا ، نُهي فيه عن المقاربة.
والحد فيما بعد أمر، وهو بيان عدد الطلاق بقوله " الطلاق مرتان " الآية، وما كان أمراً نهي عنه عن الاعتداء وهو مجاوزة الحد.
- قوله تعالى: ( ولكن ليطمئن قلبي ) .
قاله مع أن قلبه مطمئن بقدرة الله تعالى على الإحياء ، ليطمئن قلبه بعلم ذلك عيانا كما اطمأن به برهاناً ، أو ليطمئن بأنه اتخذه خليلاً ، أو بأنه مستجاب الدعوة.
- قوله تعالى: ( الذين يأكلون الربا ) .
خص الأكل بالذكر مع أن غيره كاللبس، والادخار، والهبة كذلك، لأنه أكثر وأهم انتفاعاً بالمال ، إذ لا بد منه ، أو أريد بالأكل الانتفاع ، كما يقال: فلان أكل ماله ، إذا انتفع به في الأكل وغيره.
- قوله تعالى: ( ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) .
إن قلت: كيف قال ذلك، مع أن مرتكب الكبيرة كالذي يأكل الربا لا يخلد في النار؟
قلت: الخلود يقال لطول البقاء ، وإن لم يكن بصيغة التأبيد ، كما يقال: خلد الأمير فلاناً في الحبس إذا أطال حبسه.
أو المراد بقوله " ومن عاد " العائد إلى استحلال أكل الربا ، وهو بذلك كافر، والكافر مخلد في النار على التأبيد.
- قوله تعالى: ( فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ) .
قدم المغفرة في هذه السورة وغيرها ، إلا في " المائدة " فقدم العذاب، لأنها في المائدة نزلت في حق السارق والسارقة ، وعذابهما يقع في الدنيا فقدم العذاب ، وفي غيرها قدمت المغفرة رحمة منه للعباد ، وترغيبا لهم إلى المسارعة إلى موجباتها.
- قوله تعالى: ( آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه ) .
إن قلت: أي فائدة في هذا الإخبار مع أن الأنبياء في أعلى درجات الإيمان؟
قلت: فائدته أن يبين للمؤمنين زيادة شرف الإيمان ، حيث مدح به خواصه ورسله، ونظيره في " الصافات " أنه ذكر في كل نبي " إنه من عبادنا المؤمنين ".
- قوله تعالى: ( قال كذلك الله يفعل ما يشاء ) .
قال في حق زكريا " يفعل " وفي حق مريم بعد " يخلق " مع اشتراكهما في بشارتهما بولد ، لأن استبعاد زكريا لم يكن لأمر خارق ، بل نادر بعيد فحسن التعبير بـ " يفعل " ، واستبعاد مريم كان لأمر خارق، فكان ذكر " الخلق " أنسب.
- قوله تعالى: ( إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم ) .
إن قلت: كيف قاله وآدم خلق من التراب، وعيسى ليس كذلك ، وآدم خلق من غير أب وأم، وعيسى خلق من أم؟
قلت: المراد تشبيهه به في الوجود بغير أب ، والتشبيه لا يقتضي المماثلة من جميع الوجوه.
- قوله تعالى: ( وله أسلم من في السموات والأرض طوعا وكرها ) .
إن قلت: كيف قال ذلك ، مع أن أكثر الإنس والجن كفرة ؟
قلت: المراد بهذا الاستسلام والانقياد لما قدّره عليهم ، من الحياة والموت، والمرض والصحة ، والشقاء والسعادة، ونحوها.
- قوله تعالى: ( إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم ) .
إن قلت: كيف قال ذلك، مع أن المرتد وإن ازداد ارتداده مقبول التوبة ؟
قلت: الآية نزلت في قوم ارتدوا، ثم أظهروا التوبة بالقول، لستر أحوالهم، والكفر في ضمائرهم.
- قوله تعالى: ( خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ) أي حواء.
فإن قلت: إذا كانت حواء مخلوقة من " آدم " ونحن مخلوقون منه أيضا، تكون نسبتها إليه نسبة الولد ، فتكون أختا لنا ، لا أما ؟
قلت: خلقها من آدم لم يكن بتوليد ، كخلق الأولاد من الآباء فلا يلزم منه ثبوت حكم البنتية والأختية فيها.
- قوله تعالى: ( إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ) .
أي إنما قبولها عليه لا وجوبها، إذ وجوبها إنما هو على العبد، وتوبة الله رجوعه على العبد بالمغفرة والرحمة.
- قوله تعالى: ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) .
تقييد القصر بالخوف جرى على الغالب ، فلا مفهوم له، إذ للمسافر القصر في الأمن أيضا.
- قوله تعالى: ( من يعمل سوء يجز به ) .
أي إن مات مصرا عليه ، فإن تاب منه لم يجز به.
- قوله تعالى: ( فإن كان لكم فتح من الله ) .
سمّى ظفر المسلمين فتحاً ، وظفر الكافرين نصيباً بعده ، تعظيما لشأن المسلمين، وتحقيراً لحظ الكافرين، لتضمن الأول نصرة دين الله ، وإعلاء كلمته، ولهذا أضاف الفتح إليه تعالى ، وحظ الكافرين في ظفرهم دنيوي.
- قوله تعالى: ( وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم ) .
خص الساكن بالذكر دون المتحرك ، لأن الساكن من المخلوقات أكثر عددا من المتحرك ، أو لأن كل متحرك يصير إلى السكون من غير عكس ، أو لأن السكون هو الأصل والحركة حادثة عليه.
- قوله تعالى: ( ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ).
أي مولى جميع الخلق، وهذا لا ينافي قوله " وأن الكافرين لا مولى لهم " لأن المراد بالمولى هنا: المالك، أو الخالق، أو المعبود ، وفي الآية الثانية " الناصر" .
- قوله تعالى: ( كذلك زُيّن للكافرين ما كانوا يعملون ) .
المُزين لهم هو الله لقوله تعالى : " زينا لهم أعمالهم " أو الشيطان لقوله تعالى: " وزيّن لهم الشيطان أعمالهم " وكلٌ صحيح ، فالتزيين من الله بالإيجاد والخلق، ومن الشيطان بالإغواء والوسوسة.
- قوله تعالى: ( والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ) .
جمع ميزان القيامة مع أنه واحد، باعتبار تعدد ما يوزن به من الأعمال، أو باعتبار أنه يقوم مقام موازين كثيرة، لأنه يميز الذرة وما هو كالجبال.
فإن قلت: الأعمال أعراض فكيف توزن ؟
قلت: يصيرها الله أجساما ، أو الموزون صحائفها .
- قوله تعالى: ( كما بدأكم تعودون ) .
إن قلت: كيف قال ذلك، مع أنه تعالى بدأنا أولا نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، ثم عظاما، ثم لحما، ونحن نعود بعد الموت كذلك ؟
قلت: معناه: كما بدأكم من تراب كذلك تعودون منه ، أو كما أوجدكم بعد العدم، كذلك يعيدكم بعده .
- قوله تعالى: ( وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ) .
إن قلت: قد عذبهم الله يوم بدر والنبي - صلى الله عليه وسلم - فيهم؟
قلت: المراد " وأنت فيهم " مقيم بمكة ، وتعذيبهم ببدر إنما كان بعد خروجه من مكة.
أو المراد: ما كان الله ليعذبهم العذاب الذي طلبوه وهو إمطار الحجارة وأنت فيهم.
- قوله تعالى: ( وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ) .
إن قلت: فائدة تقليل الكفار في أعين المؤمنين ظاهر، وهو زوال الرعب من قلوب المؤمنين، فما فائدة تقليل المؤمنين في أعين الكفار في قوله " ويقللكم في أعينهم " ؟
قلت: فائدته ألا يبالغوا في الاستعداد لقتال المؤمنين، لظنهم كمال قدرتهم فيقدموا عليهم، ثم تفجؤهم كثرة المؤمنين، فيدهشوا، ويتحيروا، ويفشلوا.
- قوله تعالى: ( ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ) .
أي لا تتنازعوا في أمر الحرب ، بأن تختلفوا فيه ، وإلا فالمنازعة في إظهار الحق مطلوبة، كما قال تعالى: (وجادلهم بالتي هي أحسن) .
- قوله تعالى: ( المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض ) .
إن قلت: كيف قال ذلك هنا بـ " من " وقال في قوله ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) بلفظ " أولياء " مع أن " من " أدل على المجانسة ، لاقتضائها البعضية ، فكانت بالمؤمنين أولى ، لأنهم أشد تجانسا في الصفات ؟
قلت: المراد بقوله " بعضهم من بعض " على دين بعض ، لأن " من " تأتي بمعنى " على " كما في قوله تعالى ( ونصرناه من القوم ) وقوله ( للذين يؤلون من نسائهم ) أي يحلفون على عدم وطئهن ، والمراد بقوله (بعضهم أولياء بعض) أنصارهم وأعوانهم في الدين، وعلى ذلك فكل من اللفظين يصلح مكان الآخر، لكن للولاية شرف، فكانت أولى بالمؤمنين والمؤمنات.
- قوله تعالى: ( أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ) .
أي المنافقون والمنافقات حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، أما حبطها في الدنيا، فمن حيث كيدهم ومكرهم وخداعهم، التي كانوا يقصدون بها إطفاء نور الله ، ويأبى الله إلا أن يتم نوره.
وأما حبطها في الآخرة، فمن حيث إن عباداتهم وطاعاتهم، أتوا بها رياء وسمعة ونفاقا، فحبطت أعمالهم من الخبيثات المذكورات، حيث لم يحصل بها غرضهم في الدنيا ولا في الآخرة .
- قوله تعالى: ( يفصل الآيات لقوم يعلمون ) .
خص التفصيل بالعلماء مع أنه تعالى فصل الآيات للجهلاء أيضا، لأن انتفاعهم بالتفصيل أكثر.
- قوله تعالى: ( إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ) .
قال ذلك هنا، وقال في سورة المنافقين " ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين " لأن المراد هنا، العزة الخاصة بالله وهي: عزة الإلهية، والخلق، والإماتة، والإحياء، والبقاء الدائم، وشبهها.
وهناك العزة المشتركة ، وهي في حق الله تعالى: القدرة ، والغلبة.
وفي حق رسوله - صلى الله عليه وسلم -: علو كلمته ، وإظهار دينه.
وفي حق المؤمنين: نصرهم على الأعداء.
- قوله تعالى: ( قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ) .
إن قلت: لم أضاف الدعوة إليها، مع أنها إنما صدرت من موسى عليه السلام، لآية " وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة " ؟
قلت: أضافهما إليهما لأن " هارون " كان يؤمن على دعاء موسى، والتأمين دعاء في المعنى، أو لأن هارون دعا أيضا مع موسى ، إلا أنه تعالى خص موسى بالذكر، لأنه كان أسبق بالدعوة ، أو أحرص عليها.
- قوله تعالى: ( فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك ) .
إن قلت: " إن " للشك ، والشك في القرآن منتف عنه - صلى الله عليه وسلم - قطعا، فكيف قال الله ذلك له ؟
قلت: لم يقل له ، بل لمن كان شاكا في القرآن ، وفي نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم -، ولا ينافيه قوله " مما أنزلنا إليك " لوروده في قوله " وأنزلنا إليكم نورا مبينا " وقوله " يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة ".
وقيل: الخطاب للنبي - صلى الله عليه وسلم - والمراد غيره، كما في قوله تعالى " يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ".
أو المراد إلزام الحجة على الشاكين الكافرين، كما يقول لعيسى عليه السلام " أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله "؟ وهو عالم بانتفاء هذا القول منه، لإلزام الحجة على النصارى.
- قوله تعالى: ( خالدين فيها ما دامت السموات والأرض ).
إن قلت: كيف قال ذلك، مع أن السموات والأرض يفنيان، وذلك ينافي الخلود الدائم؟
قلت: هذا خرج مخرج الألفاظ، التي يعبر العرب فيها عن إرادة الدوام، دون التأقيت، كقولهم: لا أفعل هذا ما اختلف الليل والنهار، وما دامت السموات والأرض، يريد لا يفعله أبدا.
أو أنهم خوطبوا على معتقدهم أن السموات والأرض لا يفنيان.
أو أن المراد سموات الآخرة وأرضها، قال تعالى " يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات " وتلك دائمة لا تفنى.
إن قلت: إذا كان المراد بما ذكر الخلود الدائم، فما معنى الاستثناء في قوله " إلا ما شاء ربك " ؟
قلت: هو استثناء من الخلود في عذاب أهل النار ومن الخلود في نعيم أهل الجنة، لأن أهل النار لا يخلدون في عذابها وحده، بل يعذبون بالزمهرير، وبأنواع أخر من العذاب، وبما هو أشد من ذلك، وهو سخط الله عليهم.
وأهل الجنة لا يخلدون في نعيمها وحده، بل ينعمون بالرضوان، والنظر إلى وجهه الكريم، وغير ذلك، كما دل عليه قوله تعالى (عطاء غير مجذوذ) .
أو " إلا " بمعنى غير، أي خالدين فيها ما دامت السموات والأرض، غير ما شاء الله من الزيادة عليهما، إلى ما لا نهاية له.
أو " إلا " بمعنى الواو، كقوله تعالى ( إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ) .
- قوله تعالى: ( وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون) .
" وأوحينا إليه " أي وحي إلهام لا وحي رسالة، لأنه يومئذ لم يكن بالغا ، ووحي الرسالة إنما يكون بعد الأربعين.
- قوله تعالى: ( قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم ) .
إن قلت: كيف قال ذلك ، مع أن الأنبياء عليهم السلام أعظم الناس زهدا في الدنيا، ورغبة في الآخرة ؟
قلت: إنما طلب ذلك ليتوصل به، إلى إمضاء أحكام الله تعالى، وإقامة الحق، وبسط العدل ونحوه، ولعلمه أن أحدا غيره لا يقوم مقامه في ذلك.
- قوله تعالى: ( ثم أذّن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون ) .
إن قلت: كيف جاز ليوسف أن يأمر المؤذن بأن يقول ذلك، مع أن فيه بهتانا، واتهام من لم يسرق بأنه سرق ؟
قلت: إنما قاله " تورية " عما جرى منهم مجرى السرقة، من فعلهم بيوسف ما فعلوا أولا ، أو كان ذلك القول من المؤذن، بغير أمر يوسف عليه السلام.
- قوله تعالى: ( وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو) .
إن قلت: لم ذكر " يوسف " عليه السلام نعمة الله عليه في إخراجه من السجن، دون إخراجه من الجب، مع أنه أعظم نعمة ، لأن وقوعه في الجب كان أعظم خطرا؟
قلت: لأن مصيبة السجن كانت عنده أعظم، لطول مدتها، ولمصاحبته الأوباش وأعداء الدين فيه، بخلاف مصيبة الجب، لقصر مدتها، ولكون المؤنس له فيه جبريل عليه السلام، وغيره من الملائكة.
أو لأن في ذكر الجب " توبيخا وتقريعا " لإخوته ، بعد قوله: " لا تثريب عليكم اليوم ".
- قوله تعالى: ( أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ) .
إن قلت: كيف قال يوسف ذلك، مع علمه بأن كل نبي لا يموت إلا مسلما ؟
قلت: قاله إظهارا للعبودية والافتقار، وشدة الرغبة في طلب سعادة الخاتمة، وتعليما للأمة، وطلبا للثواب.
- قوله تعالى: ( وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب ) .
إن قلت: " أو " للشك ، وهو على الله محال، فما معنى ذلك ؟
قلت: " أو " هنا بمعنى الواو، أو للشك بالنسبة إلينا، أو بمعنى " بل " ونظير ذلك قوله تعالى: ( وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون) ، وقوله : ( فهي كالحجارة أو أشد قسوة ) .
- قوله تعالى: ( سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى .) .
قال " بعبده " دون نبيه أوحبيبه، لئلا تضل به أمته، كما ضلت أمة المسيح، حيث دعته إلها ، أو لأن وصفه بالعبودية، المضافة إلى الله تعالى أشرف المقامات، وقال " ليلا " منكرا، ليدل على قصر زمن الإسراء، مع أن بين مكة وبيت المقدس، مسيرة أربعين ليلة، لأن التنكير يدل على البعضية.
والحكمة في إسرائه - صلى الله عليه وسلم - من بيت المقدس، دون مكة، لأنه محشر الخلائق، فيطؤه بقدمه ليسهل على أمته يوم القيامة، وقوفهم ببركة أثر قدمه.
أو لأنه مجمع أرواح الأنبياء، فأراد الله أن يشرفهم بزيارته - صلى الله عليه وسلم -.
- قوله تعالى: ( الذي باركنا حوله ) .
هو أعم من أن يقال: باركنا عليه، أو فيه، لإفادته شمول البركة، لما أحاط بالمسجد من أرض الشام بالمنطوق، وللمسجد بمفهوم الأولى.
- قوله تعالى: ( ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ) .
هو أعم من أن يقال: " ولا تزنوا " ليفيد النهي عن مقدمات الزنا، كاللمس والقبلة بالمنطوق، وعن الزنا بمفهوم الأولى.
- قوله تعالى: ( أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها ) .
قاله الخضر في خرق السفينة، وقال في قتل الغلام " فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه " وفي إقامة جدار اليتيمين " فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما ".
لأن الأول في الظاهر إفساد محض، فأسنده إلى نفسه.
وفي الثالث إنعام محض، فأسنده إلى ربه تعالى.
وفي الثاني إفساد من حيث القتل، وإنعام من حيث التبديل، فأسنده إلى ربه ونفسه، كذا قيل في الأخيرة.
والأوجه فيه ما قيل: إنه عبر عن نفسه فيه بلفظ الجمع، تنبيها على أنه من العظام في علوم الحكمة ، فلم يقدم على القتل إلا لحكمة عالية.
- قوله تعالى: ( يرثني ويرث من آل يعقوب ) .
أي يرث العلم والنبوة لا المال، لحديث " نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة ".
- قوله تعالى: ( قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا ) .
إن قلت: كيف قالت مريم ذلك، مع أنه إنما يتعوذ من الفاسق لا من التقي؟
قلت: معناه إن كنت ممن يتقي الله، فأنت تنتهي عني بتعوذي بالله منك.
- قوله تعالى: ( فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى ) .
إن قلت: الخطاب لآدم وحواء، فكيف قال: " فتشقى " دون فتشقيا ؟
قلت: قال ذلك لأن الرجل قيم امرأته، فشقاؤه يتضمن شقاءها، كما أن سعادته تتضمن سعادتها ، أو قاله رعاية للفواصل، أو لأنه أراد بالشقاء: الشقاء في طلب القوت، وإصلاح المعاش، وذلك وظيفة الرجل دون المرأة.
- قوله تعالى: ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ).
إن قلت: لم قدم المرأة في آية " حد الزنى " وأخرت في آية " حد السرقة " ؟
قلت: لأن الزنى إنما يتولد من شهوة الوقاع، وهي في المرأة أقوى وأكثر، والسرقة إنما تتولد من الجسارة والقوة والجرأة، وهي من الرجل أقوى وأكثر.
فإن قلت: فلم قدم الرجل في قوله تعالى ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ) ؟
قلت: لأن تلك الآية في الحد، والمرأة هي الأصل فيه لما مر، وهذه الآية في حكم النكاح، والرجل هو الأصل فيه، لأنه الراغب في الطلب، بخلاف الزنى فإن الأمر فيه بالعكس غالبا.
- قوله تعالى: ( قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ) .
إن قلت: كيف قال موسى " وأنا من الضالين " والنبي لا يكون ضالا ؟
قلت: أراد به وأنا من الجاهلين ، أو من الناسين كقوله تعالى: ( أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ) أو من المخطئين لا من المتعمدين، كما يقال:
ضل عن الطريق إذا عدل عن الصواب إلى الخطأ.
- قوله تعالى: ( إني لا يخاف لدي المرسلون . إلا من ظلم ).
إن قلت: كيف وجه صحة الاستثناء فيه، مع أن الأنبياء معصومون من المعاصي ؟
قلت: الاستثناء منقطع، أي لكن من ظلم من غير الأنبياء فإنه يخاف ، فإن تاب وبدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم ، أو متصل بحمل الظلم على ما يصدر من الأنبياء من ترك الأفضل ، أو " إلا " بمعنى " ولا " كما في قوله تعالى: ( لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا ) .
وإنما خص المرسلين بالذكر ؟
لأن الكلام في قصة موسى - وكان من المرسلين - وإلا فسائر الأنبياء كذلك، وإن لم يكن بعضهم رسلا.
- قوله تعالى: ( وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ).
هي من معجزات الإيجاز، لاشتمالها على أمرين، ونهيين، وخبرين متضمنين بشارتين، في أسهل نظم، وأسلس لفظ، وأوجز عبارة.
فإن قلت: ما فائدة وحي الله تعالى إلى أم موسى بإرضاعه، مع أنها ترضعه طبعا وإن لم تؤمر بذلك ؟
قلت: أمرها بإرضاعه ليألف لبنها، فلا يقبل ثدي غيرها بعد وقوعه في يد فرعون، فلو لم يأمرها به ربما كانت تسترضع له مرضعة، فيفوت المقصود.
- قوله تعالى: ( قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة ) .
ختم آية الليل بقوله " أفلا تسمعون " وآية النهار بقوله " أفلا تبصرون " لمناسبة الليل المظلم الساكن للسماع، ومناسبة النهار النير للإبصار.
وإنما قدم الليل على النهار، ليستريح الإنسان فيه، فيقوم إلى تحصيل ما هو مضطر إليه، من عبادة وغيرها بنشاط وخفة، ألا ترى أن الجنة نهارها دائم، إذ لا تعب فيها يحتاج إلى ليل يستريح أهلها فيه ؟
- قوله تعالى: ( وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله ) .
أي لبثتم في قبوركم في علم كتاب الله، أو في خبره، أو في قضاء الله.
- قوله تعالى: ( قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ) .
هو " عزرائيل " عليه السلام ، قال ذلك هنا .
قلت – سلطان - : لم يصح حديث في تسمية ملك الموت بعزرائيل .
وقال في الأنعام " حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا " .
وفي الزمر " الله يتوفى الأنفس حين موتها " ولا منافاة .
لأن الله هو المتوفي حقيقة بخلقه الموت، وبأمر الوسائط بنزع الروح - وهم غير ملك الموت أعوان له - ينزعونها من الأظافير إلى الحلقوم، وملك الموت ينزعها من الحلقوم، فصحت الإضافات كلها.
- قوله تعالى: ( يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ) .
لم يقل في ندائه " يا محمد " كما قال في نداء غيره " يا موسى، يا عيسى، يا داود " بل عدل إلى " يا أيها النبي " إجلالا له وتعظيما، كما قال: (يا أيها الرسول) ، وإنما عدل عن وصفه إلى اسمه في الإخبار عنه في قوله ( محمد رسول الله ) وقوله ( وما محمد إلا رسول ) ليعلم الناس أنه رسول الله، ليلقبوه بذلك ويدعوه به.
- قوله تعالى: ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم ) .
أي في الحرمة والاحترام، وإنما جعلهن الله كالأمهات، ولم يجعل نبيه كالأب، حتى قال: (ما كان محمد أبا أحد من رجالكم) لأنه تعالى أراد أن أمته ، يدعون أزواجه بأشرف ما تنادى به النساء وهو الأم، وأشرف ما ينادى به النبي - صلى الله عليه وسلم - لفظ " الرسول " لا الأب .
ولأنه تعالى جعلهن كالأمهات، إجلالا لنبيه، لئلا يطمع أحد في نكاحهن بعده، ولو جعله أبا للمؤمنين، لكان أبا للمؤمنات أيضا فيحرمن عليه، وذلك ينافي إجلاله وتعظيمه.
ولأنه تعالى جعله أولى بنا من أنفسنا، وذلك أعظم من الأب في القرب والحرمة، إذ لا أقرب للإنسان من نفسه، ولأن من الآباء من يتبرأ من ابنه، ولا يمكنه أن يتبرأ من نفسه.
- قوله تعالى: ( ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم ).
إن قلت: كيف علق عذابهم بمشيئته ، مع أن عذابهم متيقن الوقوع لقوله تعالى " إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار " ؟
قلت: معناه إن شاء عذابهم - وقد شاء - أو إن شاء موتهم على النفاق.
- قوله تعالى: ( لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب ) .
الفرق بين " النصب " و " اللغوب " أن النصب: تعب البدن، واللغوب: تعب النفس .
- قوله تعالى: ( هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون ) .
إن قلت: كيف قال في صفة أهل الجنة ذلك، والظل إنما يكون لا يقع عليه الشمس، ولا شمس في الجنة لقوله تعالى: " لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا "؟
قلت: ظل أشجار الجنة من نور قناديل العرش، أو من نور العرش، لئلا تبهر أبصارهم، فإنه أعظم من نور الشمس.
- قوله تعالى: ( رب السموات والأرض وما بينهما ورب المشارق ) .
إن قلت: لم جمع هنا المشارق وحذف مقابله، وثنّاه في الرحمن، وجمعه في المعارج، وأفرده في المزمل مع ذكر مقابله في الثلاثة ؟
قلت : لأن القرآن نزل على المعهود، من أساليب كلام العرب وفنونه، ومنهما الإجمال والتفصيل، والذكر والحذف، والجمع والتثنية والإفراد باعتبارات مختلفة، فأفرد .
وأجمل في المزمل، بقوله " رب المشرق والمغرب " أراد مشرق الصيف والشتاء ومغربهما .
وجمع وفصل في المعارج بقوله " فلا أ قسم برب المشارق والمغارب " أراد جميع مشارق السنة ومغاربها، وهي تزيد على سبعمائة .
وثنّى وفصّل في الرحمن بقوله " رب المشرقين ورب المغربين " أراد مشرقي الصيف والشتاء ومغربهما .
وجمع وحذف هنا بقوله " رب المشارق " أراد جميع مشارق السنة .
- قوله تعالى: ( إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب ) .
إن قلت: لم خص سماء الدنيا بزينة الكواكب، مع أن بقية السموات مزينة بذلك؟
قلت: لأنا إنما نرى سماء الدنيا، دون غيرها.
- قوله تعالى: ( وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون) .
إن قلت: " أو " للشك، وهو على الله محال ؟
قلت: " أو " بمعنى " بل " أو بمعنى الواو، أو المعنى أو يزيدون في نظرهم، فالشك إنما دخل في قول المخلوقين.
- قوله تعالى: ( قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي ) .
إن قلت: كيف قال سليمان ذلك، مع أنه يشبه الحسد والبخل بنعم الله تعالى على عباده، بما لا يضر سليمان ؟
قلت: المراد لا ينبغي لأحد أن يسلبه مني في حياتي، كما فعل الشيطان الذي لبس خاتمي، وجلس على الكرسي أو أن الله علم أنه لا يقوم غيره مقامه بمصالح ذلك المكان، واقتضت حكمته تعالى تخصيصه به، فألهمه سؤاله.
- قوله تعالى: ( إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار ) .
أي دائم على كفره وكذبه، أو لا يهديه إلى حجة يلزم بها المؤمنين، وإلا فكم هدي من كافر.
- قوله تعالى: ( وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج ) .
إن قلت: كيف قال ذلك مع أن الأنعام مخلوقة في الأرض ، لا منزلة من السماء؟
قلت: هذا من مجاز النسبة إلى سبب السبب، إذ الأنعام لما كانت لا تعيش إلا بالنبات، والنبات لا يعيش إلا بالمطر، والمطر منزل من السماء، وصفها بالإنزال، من تسمية المسبب باسم سبب سببه.
أو معناه: وقضى لكم، لأن قضاءه منزل من السماء، من حيث كتب في اللوح المحفوظ.
أو خلقها في الجنة ثم أنزلها على آدم عليه السلام، بعد إنزاله إلى الأرض، والإنزال بمعنى الإحداث والإنشاء، لقوله تعالى " يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا ".
- قوله تعالى: ( قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا ) .
أي إماتتين وإحيائتين، لأنهم نطف أموات فأحيوا، ثم أميتوا ثم أحيوا للبعث، وهذا كقوله تعالى " كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ".
- قوله تعالى: ( يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور) .
فإن قلت: لم قدم الإناث مع أن جهتهن التأخير، ولم عرف الذكور دونهن ؟
قلت: لأن الآية سيقت لبيان عظمة ملكه ومشيئته، وأنه فاعل ما يشاء، لا ما يشاؤه عبيده كما قال " ما كان لهم الخيرة ".
ولما كان الإناث مما لا يختاره العباد، قدمهن في الذكر، لبيان نفوذ إرادته ومشيئته، وانفراده بالأمر، ونكرهن وعرف الذكور لانحطاط رتبتهن، لئلا يظن أن التقديم كان لأحقيتهن به .
ثم أعطى كل جنس حقه من التقديم والتأخير، ليعلم أن تقديمهن لم يكن لتقدمهن، بل لمقتضى، فقال " أو يزوجهم ذكرانا وإناثا " كما قال " يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ".
- قوله تعالى: ( إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون ) .
إن قلت: القرآن ليس بمجعول، لأن الجعل هو الخلق ، فلم لم يقل: قلناه أو أنزلناه؟
قلت: الجعل يأتي بمعنى القول أيضا، كقوله تعالى " ويجعلون لله البنات " وقوله " وجعلوا لله أندادا ".
- قوله تعالى: ( سيهديهم ويصلح بالهم ) .
إن قلت: كيف قال ذلك تعالى في حق الشهداء، بعدما قُتلوا، مع أن الهداية إنما تكون قبل الموت لا بعده؟
قلت: معناه سيهديهم إلى محاجة منكر ونكير، وقيل: سيهديهم يوم القيامة إلى طريق الجنة.
- قوله تعالى: ( ويهديك صراطا مستقيما ) .
أي يزيدك هدى، وإلا فهو مهدي.
- قوله تعالى: ( ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ) أي صنفين.
فإن قلت: كيف قال ذلك، مع أن العرش، والكرسي، واللوح، والقلم، لم يخلق من كل منها إلا واحد؟
قلت: معناه ومن كل حيوان خلقنا ذكرا وأنثى، ومن كل شيء يشاهدونه خلقنا صنفين، كالليل والنهار، والنور والظلمة، والصيف والشتاء، والخير والشر، والحياة والموت، والشمس والقمر.
- قوله تعالى: ( خلق الإنسان من صلصال كالفخار) .
أي من طين يابس لم يطبخ، له صلصلة أي صوت إذا نقر.
فإن قلت: كيف قال ذلك هنا، وقال في الحجر " من صلصال من حمإ مسنون " أي من طين أسود متغير، وقال في الصافات " من طين لازب " أي لازم يلصق باليد، وقال في آل عمران " كمثل آدم خلقه من تراب "؟!
قلت: الآيات كلها متفقة المعنى، لأنه تعالى خلقه من تراب، ثم جعله طينا، ثم حمأ مسنونا، ثم صلصالا.
- قوله تعالى: ( سنفرغ لكم أيها الثقلان) .
أي سنقصد لحسابكم، فهو وعيد وتهديد لهم، فالفراغ هنا بمعنى القصد للشيء، لا بمعنى الفراغ منه، إذ معنى الفراغ من الشيء، بذل المجهود فيه، وهذا لا يقال في حقه تعالى.
- قوله تعالى: ( ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد ) .
إن قلت: كيف خص عيسى " أحمد " بالذكر دون " محمد " مع أنه أشهر أسماء النبي - صلى الله عليه وسلم -؟
قلت: خصه بالذكر لأنه في الإنجيل مسمى بهذا الاسم، ولأن اسمه في السماء أحمد، فذكر باسمه السماوي، لأنه أحمد الناس لربه، لأن حمده لربه بما يفتحه الله عليه يوم القيامة من المحامد، قبل شفاعته لأمته، سابق على حمدهم له تعالى، على طلبه الشفاعة من نبيه - صلى الله عليه وسلم - لهم.
- قوله تعالى: ( ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم ) .
" ذلك بأنهم " أي المنافقين " آمنوا ثم كفروا " أي آمنوا بألسنتهم، وكفروا بقلوبهم، ف " ثم " للترتيب الإخباري لا الإيجادي.
- قوله تعالى: ( ومن يؤمن بالله يهد قلبه ) .
إن قلت: كيف قال ذلك، مع أن الهداية سابقة على الإيمان ؟
قلت: ليس المراد يهد قلبه للإيمان، بل المراد يهده لليقين عند نزول المصائب، فيعلم أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه، أو يهده للرضى والتسليم عند وجود المصائب، أو للاسترجاع عند نزولها بأن يقول: " إنا لله وإنا إليه راجعون ".
- قوله تعالى: ( سيجعل الله بعد عسر يسرا ) .
لا ينافي قوله " إن مع العسر يسرا " لأن " مع " بمعنى بعد، وإلا فيلزم اجتماع الضدين وهو محال.
- قوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا ) .
لم يقل نصوحة ، لأن " فعولا " يستوي فيه المذكر والمؤنث، كقولهم: امرأة صبور وشكور.
- قوله تعالى: ( وصدّقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين) .
إن قلت: القياس من القانتات، فلم عدل عنه إلى القانتين؟
قلت: رعاية للفواصل، أو معناه من القوم القانتين.
- قوله تعالى: ( الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ) .
قدم الموت لأنه هو المخلوق أولا، لقوله تعالى " وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ".
- قوله تعالى: ( ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ) .
أي من خلل وعيب، وإلا فالتفاوت بين المخلوقات، بالصغر والكبر وغيرهما كثير.
- قوله تعالى: ( وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ) .
إن قلت: كيف دعا نوح على قومه بذلك، مع أنه أرسل إليهم ليهديهم ويرشدهم ؟
قلت: إنما دعا عليهم بذلك، بعد أن أعلمه الله تعالى أنهم لا يؤمنون.
- قوله تعالى: ( إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ) .
وصف القرآن بالثقل، لثقله بنزول الوحي على نبيه، حتى كان يعرق في اليوم الشاتي، أو لثقل العمل بما فيه، أو لثقله في الميزان، أو لثقله على المنافقين.
- قوله تعالى: ( نحن خلقناهم وشددنا أسرهم ) أي خلقهم.
فإن قلت: كيف قال ذلك هنا، وقال في النساء " وخلق الإنسان ضعيفا "؟
قلت: قال الزجاج: معناه يغلبه هواه وشهوته ، فلذلك وصف بالضعف .
ومعنى قوله " وشددنا أسرهم " ربطنا أوصالهم بعضها إلى بعض بالعروق والأعصاب، أو المراد بالأسر: عجب الذنب، لأنه لا يتفتت في القبر.
- قوله تعالى: ( ووجدك ضالاً فهدى ) .
أي بحق معالم النبوة، وأحكام الشريعة فهداك إليها، أو ضالا في صغرك في شعاب مكة، فردك إلى جدك عبد المطلب، أو وجدك ناسياً فهداك إلى الذكر.
لأن الإضلال جاء بمعنى النسيان، كما في قوله تعالى " أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى " وإنما جمع بينهما في قوله تعالى " لا يضل ربي ولا ينسى " لأن الضلال ليس بمعنى النسيان، بل بمعنى الخطأ أو الغفلة.
- قوله تعالى: ( يتلو صحفاً مطهرة ) .
إن قلت: ظاهره أنه يقرأ المكتوب من الكتاب، مع أنه منتف في حقه - صلى الله عليه وسلم - لكونه أمياً ؟
قلت: المراد يتلو ما في الصحف عن ظهر قلبه.
فإن قلت: ما الفرق بين الصحف والكتب حتى جمع بينهما في الآية ؟
قلت : الصحف قراطيس ( مطهرة ) من الشرك والباطل، والكتب بمعنى المكتوبات، أي في القراطيس مكتوبة ( قيمة ) أي مستقيمة، ناطقة، بالعدل والحق.
- قوله تعالى: ( فويل للمصلين . الذين هم عن صلاتهم ساهون ) .
فإن قلت: كيف توعد الله الساهي عن الصلاة، مع أنه غير مؤاخذ بالسهو، لخبر " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان "؟
قلت: المراد بالسهو هنا: التغافل والتكاسل عن أدائها، وقلة الالتفات إليها، وذلك فعل المنافقين، أو الفسقة من المسلمين، لا ما يتفق فيها من السهو بالوسوسة، أو حديث النفس عما لا صنع للعبد فيه.
- قوله تعالى: (تبت يدا أبي لهب وتب) .
ليس بتكرار مع ما بعده، لأنه دعاء، والثاني خبر، فقد تب أي خسر، وقيل: " تبت يدا أبي لهب " أي عمله " وتب " أبو لهب.
إن قلت: كيف ذكره الله تعالى بكنيته، دون اسمه وهو " عبد العزى " مع أن ذلك إكرام واحترام ؟
قلت: لأنه لم يشتهر إلا بكنيته، أو لأن ذكره باسمه خلاف الواقع حقيقة، لأنه عبد الله لا عبد العزى، أو لأنه ذكره بكنيته، لموافقة حاله لها، فإن مصيره إلى النار ذات اللهب، وإنما كني بذلك لتلهب وجنتيه وإشراقهما.
- قوله تعالى: ( من شر ما خلق . ومن شر غاسق إذا وقب ) .
" من شر " كرره أربع مرات، لأن شر كل منهما غير شر البقية عنها.
فإن قلت: أولها يشمل البقية، فما فائدة إعادتها ؟
قلت: فائدتها تعظيم شرها، ودفع توهم أنه لا شر لها لخفائه فيها.
فإن قلت: كيف عرف " النفاثات " ونكر ما قبلها وما بعدها ؟
قلت: لأن كل نفاثة لها شر، وليس كل غاسق وحاسد له شر، والغاسق: الليل.
 مكتبة الصوتيات
مكتبة الصوتيات
المستشار الناجح
0:00
كيف تقوي إيمانك
0:00
تأملات في سورة التكاثر
0:00
تأملات في سورة الصف
0:00
تلاوة من سورة آل عمران 8-9
0:00
عدد الزوار
7427871
إحصائيات |
مجموع الكتب : ( 44 ) كتاب |
مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم |
مجموع المقالات : ( 1713 ) مقال |
مجموع الصوتيات : ( 992 ) مادة |